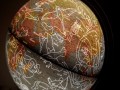الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
مطلوب: مدحت باشا لبنانيّ
مطلوب: مدحت باشا لبنانيّ

حازم صاغية
بقلم - حازم صاغية
تعبير «كسب ثقة المجتمع الدوليّ» رائج في لبنان اليوم. رؤساء العهد ووزراء الحكومة مُطالَبون به. إن لم يكسبوا ثقة المجتمع الدوليّ، كما يقال، فالكارثة سوف تحلّ. هذه الثقة ينبغي الحصول عليها، بغضّ النظر عن فساد السياسيين وعن سلاح المقاومة. ولأجل ذلك، ينبغي أن «نظهر» على هيئة أخرى تقنع «المجتمع الدوليّ» بأنّ ما من فساد في الحكم وما من سلاح في يد المقاومة.
مدحت باشا اسم يعرفه كلّ من يلمّ ببعض التاريخ العثماني المتأخّر. هو أيضاً عمل على «كسب ثقة المجتمع الدوليّ». ومثلما يقال: «لم يترك قدامى اليونان شيئاً إلَّا قالوه»، يمكننا أن نقول: كلّ ما نعيشه اليوم سبق أن عاشه أجدادنا مع السلطنة العثمانيّة في الـ150 سنة الأخيرة من حياتها.
فليعذرنا القارئ إذاً على بعض الإطالة في تعريف مدحت باشا. ذاك أنّنا، في لبنان، نحتاج على نحو قاهر ومُلحّ، إلى من يؤدّي دوره الخطير في «كسب ثقة المجتمع الدوليّ».
لقد عُدّ مدحت الرجل القوي ورمز الإصلاح في السلطنة إبّان عقودها الأخيرة: بدأ حياته العامّة موظّفاً لدى الباب العالي، ثمّ زار أوروبا وهو في السادسة والثلاثين حيث قضى ستة أشهر. وفي وقت لاحق أبدى كفاءة إداريّة بعيدة كحاكم لبغداد. كان يحمل أفكاراً متقدّمة حول أهميّة الدستور، والحدّ من سلطة السلطان، واللامركزيّة، والمساواة بين المواطنين بمعزل عن أديانهم.
لكنْ لماذا صار مدحت صدراً أعظم بعدما كان مستبعداً؟ ولماذا صدر الدستور العثمانيّ، بُعيد تعيينه، في أواخر 1876.
دور مدحت ودستوره الجديد لم ينجم عن تطوّر تركي داخليّ، لا سيّما في بيئة السلطة نفسها. هكذا شكّك المشكّكون بأنّ الأمر لا يعدو كونه شكلاً ومظهراً لتهدئة القوى الغربيّة ولإقناعها بأنّ السلطنة اتّبعت فعلاً طريق الإصلاحات. ما أعطى بعض الوجاهة لتلك الانتقادات كان أحداثاً سبقت تعيين مدحت وصدور دستوره، في عدادها القمع الذي تعرّضت له انتفاضات المناطق البلقانيّة، ثمّ هزيمة الصرب في الحرب التي بدأوها على الإمبراطوريّة في يونيو (حزيران) 1876، ما أثار أزمة دوليّة كبرى. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه كانت روسيا تتهيّأ للحرب ضدّ جارها الجنوبيّ، فأوضح بنجامين دزرائيلي، رئيس الحكومة البريطاني حينذاك، أنّ بريطانيا لن تقبل بتقسيم الإمبراطوريّة العثمانيّة. بعد أشهر، وكمحاولة أخيرة لتفادي الحرب، انعقد مؤتمر للقوى الأوروبيّة في إسطنبول لبحث شروط السلام بين روسيا وصربيا، ولإعادة تنظيم أقاليم البلقان مع إصلاحات تشرف عليها وتضمنها القوى الدوليّة.
قبل يوم واحد على انعقاد ذاك المؤتمر عُيّن مدحت صدراً أعظم، فارتبط التعيين والدستور بالحاجة إلى كسب رضا القوى الأوروبيّة في وجه روسيا، وإقناعها بعدم التدخّل لمصلحة الأقلّيّات. وهذا ليس بالمسار الجديد ولا بالعلاقة الجديدة مع الغرب. فالقرن التاسع عشر سبق أن شهد محاولتين إصلاحيّتين على الأقلّ كانتا محكومتين بالسبب نفسه: في 1839 بعد الهزيمة أمام محمد علي، وفي 1856 بُعيد حرب القرم والحاجة إلى التوصّل مع القوى الأوروبيّة إلى معاهدة سلام ملائمة.
لكنّ الدستور، أقلّه في نظر مدحت، لم يكن فحسب لخداع الغرب. صحيح أنّه كان ينوي الحصول على ذاك الرضا الغربيّ، لكنّه أيضاً كإصلاحي كان متأثّراً بالكتابات التي سبق لشبّان «تركيّا الفتاة» أن كتبوها في العقد السابق ثمّ ذاعت في الدوائر السياسيّة والثقافيّة.
على أنّ عبد الحميد لم يكن في وارد الإصلاح أصلاً. فهو عيّن مدحت صدراً أعظم كي يتزامن التعيين مع انعقاد مؤتمر السفراء الأجانب في إسطنبول. وإذ انتهى المؤتمر في 20 يناير (كانون الثاني) 1877، فقد سارع إلى عزل مدحت في 5 فبراير (شباط) بطريقة مهينة، وطلب منه مغادرة البلد بوصفه يمثّل خطراً على أمن الدولة، وما لبث أن عطّل العمل بالدستور. لكنّ اللعبة لم تتوقّف: فلكسب رضا الدول الغربيّة، بعد إطاحة مدحت، دعا السلطان إلى انتخابات عامّة كانت الأولى في التاريخ العثمانيّ، بل الإسلاميّ. وبالفعل انعقد البرلمان الأوّل في 19 مارس (آذار) 1877 إلاّ أنّ المشهد لم يكن جذّاباً: مجلس شيوخ من 25 عضواً معيّناً، ومجلس نوّاب من 120 عضواً «انتُخبوا» بالتزوير والقسر. لكنْ حتّى هذا المجلس - الواجهة لم يحتمله عبد الحميد، بفعل تكاثر انتقاداته للباشوات والموظّفين، وللفساد وسوء الإدارة، كما أزعجه أنّ هذا البرلمان بات ملتقى غير مسبوق لمندوبين من بغداد والقدس وأرضروم وسلونيكا. هكذا انتهى عمره القصير في 28 يونيو من العام نفسه. أُجريت انتخابات أخرى نجم عنها برلمان آخر انعقد في 13 ديسمبر (كانون الأوّل) ثم حُلّ بعد جلستين فقط. كان ذلك في 14 فبراير 1878.
مدحت اغتيل، في منفاه، في أبريل (نيسان) 1883.
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة - مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما �...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - صوت الإمارات
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©