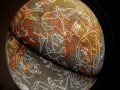الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
أبعد من ردّ عسكريّ!
أبعد من ردّ عسكريّ!

حازم صاغية
بقلم - حازم صاغية
تعاقبت الردود الإيرانيّة غير الموفّقة على مقتل قاسم سليماني ورفاقه. جنازته التي أريد لها أن تكون ردّاً جماهيريّاً مُدوّياً على الأميركيين انتهت إلى مأساة إنسانيّة. الصواريخ التي أُطلقت على موقعين عسكريين أميركيين لم تقتل أحداً. رواية الثمانين قتيلاً أميركيّاً التي عُممت وتلاها اتّهام واشنطن بإخفاء قتلاها، ما لبثت أن سُحبت من التداول. الحجج التي ذُكرت في التمييز بين قتل الجنود وإصابة المواقع أقنعت سامعيها بقدر اقتناع أصحابها بها. كارثة الطائرة المدنيّة الأوكرانيّة صار من شبه المؤكّد أنّها أهمّ ما أنجزته الصواريخ.
الردود الكلاميّة على الأميركيين كانت أقوى. اللسان بدا أنشط من الذراع. العبارات التي نُقلت عن المرشد علي خامنئي وعن بعض القادة العسكريين في إيران، والتصريحات الملتهبة التي أدلى بها صحافيّون وسياسيون و«استراتيجيّون» عرب تابعون لطهران، فاقت الصواريخ التعيسة صاروخيّة. لقد وعدتنا بردّ يُنهي الوجود الأميركي في المنطقة ويمهّد لما لا يقلّ عن تحرير فلسطين وإزالة الدولة العبريّة. بالمناسبة، كان هذا خطأ «تكتيكيّاً» فادحاً، إذ رَفَع سقف التوقّعات إلى حدّ يعجز أي ردّ جدّي عن اللحاق به. كيف، إذاً، والردّ لم يكن جدّيّاً؟
لقائل أن يقول: لكنّ إيران ستردّ بعد حين، وسوف يكون ردّها مؤلماً للأميركيين. ربّما. لكنّ ما حصل حتّى الآن، وقبله تراث الردود المشابهة التي عرفناها في تاريخ المنطقة الحديث، يقطعان بضرورة المراجعة لفكرة «الردّ». إنّها أبعد من عمل عسكري، فاشلاً كان أو ناجحاً. هي أبعد في الخلفيّات التي تتحكّم بها، وأبعد في النتائج التي تفضي إليها.
بلغة أخرى، ومنذ عشرات السنين، نحن موعودون بـ«ردّ» على الغرب وأميركا: «ردّ حضاريّ». «ردّ ثقافيّ». «ردّ اقتصاديّ». «ردّ سياسي وعسكريّ». البعض يريد أن يردّ على السنوات الإمبرياليّة في الـ150 سنة الأخيرة، وفي القلب منها نشأة إسرائيل عام 1948. بعض آخر تذهب به الرغبة إلى الحروب الصليبيّة والصراع على إسبانيا – الأندلس. التواريخ المختَلف عليها ليست مهمّة. الحماسة الجامعة هي المهمّة.
طلب «الردّ»، الذي تطمح الأعمال العسكريّة لأن تكون ترجمته التنفيذيّة، هو من أكثر الأفكار التي تناولها ودار عليها الفكر العربي والإسلامي منذ «عصر النهضة». مع هذا، لم يتحقّق أي نجاح حقيقي على أيٍّ من جبهات الردّ العتيد. ما حصل كان بالعكس تماماً: لقد بتنا أسوأ «حضاريّاً» وثقافيّاً وسياسياً واقتصادياً وعسكريّاً دفعة واحدة. التقهقر هو وحده ما يتقدّم.
هذا التثبّت عند الردّ مَرض مؤلم بما فيه الكفاية، إلاّ أنّه ناجم عن مرض آخر لا يقلّ إيلاماً وسطوة علينا: إنّه العجز عن استيعاب أسباب «تفوّق الغرب»، وبالتالي عن التعامل العقلاني مع هذا الواقع. إرجاع تلك الأسباب إلى «القوّة العسكريّة» أو إلى «النهب» أو إلى «المؤامرات» لا يمهّد لمثل ذاك الاستيعاب. إنّه يجعله أبعد وأصعب منالاً. ذاك أنّ ما لجأنا إليه هو تغييب شريط تاريخي مديد ومزدوج، يمتدّ، من جهة، من الثورة الزراعيّة فالثورة الصناعيّة وربط أجزاء العالم اقتصادياً، وصولاً إلى الثورة ما بعد الصناعيّة، كما يمتدّ، من جهة أخرى، من الإصلاحات الدينيّة والتنوير إلى الديمقراطيّة البرلمانيّة. هذا التغييب غيّبنا نحن، إذ لم يعمل لصالح إدراك أعلى لدينا، ولم يخدم عيشنا على نحو متصالح مع هذا العالم. لكنْ فيما اعتصمت شعوبنا بحبل الغضب الذي لا يسكّنه إلاّ «الردّ»، راح الحكّام يجنون ثمار الغضب و«الردّ» في آن معاً. أنظمة استبداد تعاقبت مسلّحة بشرعيّة هزيلة هي أنّها سوف «تردّ». في هذه الغضون، كانت المسافة تتّسع يوماً بيوم «بيننا» –نحن الذين سنردّ– و«بينهم» –هم الذين سنردّ عليهم. نظرة سريعة إلى التواريخ الكبرى في منطقتنا تُظهر أي شكل تتّخذه خريطة ردودنا على تنوّعها والاختلاف بينها: مع جمال عبد الناصر وصدّام حسين وحافظ الأسد والخميني وخامنئي، فضلاً عن «القاعدة» و«داعش». وجهة الانحطاط، انحطاطنا، التي سلكتها تلك الخريطة لا يرقى إليها الشكّ.
ولأنّ الردّ عزيز علينا إلى هذا الحدّ، فيما افتقارنا لأدواته فادح إلى هذا الحدّ، باتت التضحية بالبشر، انتحاراً أو نحراً، إحدى أهمّ صناعاتنا القليلة. بموجبها يموت الناس الموعودون بالردّ، ويغدو الزعماء الواعدون به أبطالاً تاريخيين.
إنّ ما حصل قبل أيّام قليلة بين الولايات المتّحدة وإيران يستحقّ أن يشكّل مناسبة أخرى تحضّ على مراجعة هذا الحصاد الرديء. فأنْ نتصالح مع هذا العالم، أنْ نعيش بشيء من السعادة فيه، أنْ نقلّل عدد من يموتون إرضاءً لتوقنا إلى الردّ، وإشباعاً لاستبداد من يقولون به، أمور تستحقّ وقفة تفكير.
GMT 21:52 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
نفط ليبيا في مهب النهب والإهدارGMT 21:51 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
نموذج ماكينليGMT 21:51 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
أخطر سلاح في حرب السودان!GMT 21:49 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
الإرهاب الأخضر أو «الخمير الخضر»GMT 21:48 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
الإرهاب الأخضر أو «الخمير الخضر»GMT 21:48 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
اللبنانيون واستقبال الجديدGMT 21:47 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
لا لتعريب الطبGMT 21:46 2025 السبت ,25 كانون الثاني / يناير
في ذكرى صاحب المزرعةصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدأصالة تحتفل بفوزها بجائزة "جوي أوورد" للعام الثاني وتستعد لإهداء الجمهور أغنية جديدة "ممنوع"
الرياض - صوت الإمارات
الفنانة أصالة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" بعدما فازت بجائزة المغنية المفضلة للعام الثاني على التوالي، وعاشت الفنانة أصالة عام مليء بالإنجازات والأعمال الفنية المتنوعة والتي جعلتها تستحق الفو�...المزيدماسك يحذر من "هلوسة" الذكاء الاصطناعي بسبب نفاد البيانات على الإنترنت
واشنطن - صوت الإمارات
في تحذير جديد أطلقه إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا وSpaceX، حذر من خطر "هلوسة الذكاء الاصطناعي" في المستقبل القريب، وذلك بسبب احتمالية نفاد البيانات المتاحة على الإنترنت لتدريب الأنظمة الذكية. وتوقع ماسك أن الذكاء ا�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدأحلام بإطلالات ناعمة وراقية في المملكة العربية السعودية
الرياض - صوت الإمارات
النجمة الإماراتية أحلام الشامسي كشفت أخيرًا عن ألبومها الجديد لعام 2025، وأفرجت الفنانة أحلام عن أولى اللقطات من كواليس وتحضيرات ألبومها الجديد، ونشرت فيديو عبر حسابها بانستجرام شوقت به الجمهور لأعمالها ومفاجآتها الفنية الجديدة من خلال الألبوم الجديد، وكتبت أحلام في تعليقها على برومو الكليب الجديد الذي بصدد طرحه قريبًا: "أحلام 2025" والذي تكهن البعض أنه سيكون عنوان ألبومها الجديد، بالإضافة إلى تعليقها على الفيديو "صنع في السعودية"، حيث اعتبر البعض أن تلك إشارة إلى أن أحلام صنعت ألبومها الجديد بالكامل في السعودية، وبالتزامن مع تلك المناسبة دعونا نرصد أجمل إطلالات النجمة أحلام خلال الفعاليات والحفلات التي حضرتها في المملكة العربية السعودية. إطلالات ناعمة وراقية من وحي النجمة أحلام في السعودية في حفل زفاف سابق قامت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©