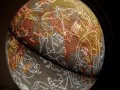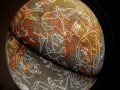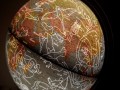الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
تربية العقل الناقد
تربية العقل الناقد

بقلم - عائشة سلطان
نردد دائماً: «لا أحد فوق القانون»، كما نسمع أنه «لا أحد فوق النقد»، إن عبارات من هذا المستوى المهم رغم تنظيرية الأمر أحياناً، لا يمكن اختبار صلاحيته واحتمالات القبول بتطبيقه من قبل الأفراد والجماعات إلا حين يتم التعامل به واقعياً، وحين يتم العمل به دون حساسيات وخلافات واختلافات، فهل حدث لأحدنا أن انتقد سلوك زميله، أو كتاب صديقه، أو عمل مديره أو أحد أصدقائه، أو أي نتاج ظهر علانية أمام الجمهور، وتم قبول ذلك النقد بالفعل، وفق مقولة: «اختلاف الآراء لا يفسد للود قضية»؟ فهل بقي الود قائماً بينك وبين أي شخص قمت بانتقاده؟
تدفعنا هذه الأسئلة أو هذه المعضلة إلى البحث في القضية الأهم: ما الذي يجعلنا مؤهلين لتقبل النقد؟ ما الذي يجعل المنهج أو الذهنية النقدية حاضرةً في المجتمع وفي العلاقات الاجتماعية، والأهم في الفضاءات المفتوحة في المجتمع التي يدور فيها ذلك النوع من الحوارات والنقاشات التي تدرِّبنا على قضية النقاش ابتداءً، ومن ثم على الجدل والاختلافات وتقبُّل الآراء والنقد برحابة صدر أو بموضوعية على الأقل بعيداً عن الشخصنة.
هل يلعب التعليم دوراً في هذا الأمر؟ من المؤكد أنه لا يمكننا الحديث عن تربية الذهنية الناقدة، التي تتقبل الآخر بأفكاره وآرائه واختلافاته بعيداً عن دور التعليم منذ المستويات الدنيا للتعليم، إضافة للفضاءات المفتوحة التي تدور فيها النقاشات والجدالات في المنتديات الثقافية، وصالونات الأدب، والقنوات الثقافية التلفزيونية، وقنوات اليوتيوب النشطة.. إلخ، شريطة أن يصل الناس لهذه المنتديات والفضاءات بسهولة ويُسر، ويتابعونها بحرية ويشتركون في حواراتها وأنشطتها دون أي شكل من أشكال الضغط أو الحظر أو المنع.
هكذا ظهرت الذهنية الحرة والشخصية الناقدة في المجتمعات الأخرى وأصبحت سمةً وسلوكاً معتبراً ومبجلاً فيها، بل وحقاً لا يمكن التنازل عنه.
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة - مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما �...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - صوت الإمارات
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©