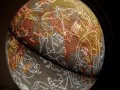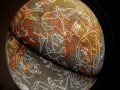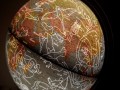الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
اللحظة التي غيّرت حياتها!
اللحظة التي غيّرت حياتها!

بقلم - عائشة سلطان
تقول الصحيفة التي نشرت الواقعة إن الفتاة سعدى كانت أكبر إخوتها الثمانية، وكانت تفتتح عامها الخامس عشر عندما حملها والدها المزارع المُعدم إلى العاصمة، وأودعها منزل سيدة أجنبية كانت تعيش هناك، كان ذلك عام 1957، بعد ثلاثة أشهر قررت السيدة العودة إلى بلادها بشكل نهائي، ما جعل الفتاة تحزم متاعها لتعود إلى قريتها، وفي الطريق دخلت دكاناً لتسأل صاحبه المساعدة في كيفية الحصول على وسيلة مواصلات تقلّها، ويا لتصاريف الحياة!
فقد غيّرت تلك اللحظة الفارقة حياتها كاملة، بعد أن أوهمها صاحب الدكان وزوجته بأن بلدتها قد دمِّرت تماماً ولم يبق منها أحد على قيد الحياة، وبأنهما مستعدان لاستبقائها عندهما، وقد كان، غيّرا اسمها، محَوَا تاريخها كاملاً وسخّراها لخدمتهما، بل وزادا بأن راحا يُعِيرانها لخدمة بقية العائلة حتى توفيّا، فورثها بقية الأبناء، وبقيت تعيش الخُدعة والمأساة حتى بلوغها سن الخامسة والستين! وعندما لم تعد صالحة لشيء تم التخلص منها برميها في دار المسنين، وهناك تكشفت الحقيقة حين طلبت الدار الأوراق الثبوتية الخاصة بالمدعوة مريم التي هي في الأصل سعدى، لتنتقل القضية إلى أروقة المحاكم، في اللحظة التي كان القضاء يقول كلمته العادلة كانت سعدى تودّع الحياة!
كيف يحدث أن يتخلى الإنسان عن إنسانيته بهذا القدر، كيف استطاع هؤلاء الذين سلبوا الفتاة شرفها وحياتها وصحتها وحتى كرامة شيخوختها أن يعتبروا أنفسهم بشراً، ناهيك عن أن يستحقوا منزلة الإنسانية ابتداءً؟ والغريب أن تتعالى أصوات كثيرة هذه الأيام تدعو الناس ألا يفكّروا بغيرهم؛ لأنهم الأهم، وما عداهم لا أهمية له.
فكّر بغيرك وأنت تعد فطورك -يقول لك محمود درويش- فطورك وليس حياتك وحقوقك وكرامتك وإنسانيتك! فهناك كثيرون حولك بإمكانك أن تغيّر حياتهم، أن تعبر بهم إلى الضفة الأخرى من الحياة، كأن تقود فتاة تائهة إلى بيتها لتعيش حقها في الحياة، كما كان على صاحب الدكان أن يفعل، بدل أن يسرق خمسين عاماً من حياتها دون أن يطرف له جفن!
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة - مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما �...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - صوت الإمارات
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©