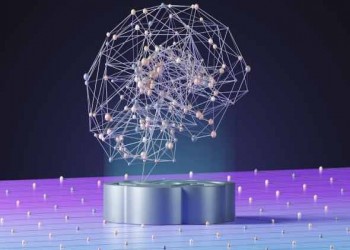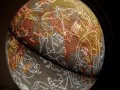الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
يثقلونه حيناً.. يبكونه دوماً
يثقلونه حيناً.. يبكونه دوماً

ناصر الظاهري
ليس من شيء أثقل على صدر إنسان ينشد الخير، ويتبع الرضا، مثل رؤية شخص ودعته الأضواء، وتناسل عنه الأصدقاء، وتنكر له المعارف، ونساه من كان يقصده في عزه ومركز عمله، وهو اليوم وحيد في تقاعده يحاول أن يتعثر في أي شيء ليعمله، ويمضي وقته بطيئاً ودون فائدة يعدها، يحاول أن يتصالح مع الأمراض التي خلفها القعود وخريف العمر، تماماً مثل مشاهدة شخص كان في يوم ما فارساً وخيّالاً من خيالي القبيلة، ينتخي إذا ما حزّت الحزّة، وسمع الصائح، وهو اليوم في الزمن الجديد يعمل حارساً لمدرسة ابتدائية تضيق به أسوارها وتصرفات العود الأخضر من الجيل الجديد، أن ترى عجوزاً كانت في صباها تزاحي الحجر، تعمل كل نهارها في البيت والنخل، وفي المساء تحمل على رأسها «قلالتين جت» مضحى لدبشها، وطفلاً على خاصرتها، تمشي من مطلع الهملة حتى المعترض، تُرَوّي من الفلج، وتصل بيتها لتعد عشاءها، تتذكرها اليوم وهي في وحدتها وقد تناثر أبناؤها، ولم يتبق لها إلا خادمة إندونيسية تحاضيها وتراعيها، وتذكّرها بدوائها!
إذا كان النسيان والجحود يثقل القلب، فكيف بالعقوق والنكران؟ مثل ذلك الشايب المرمي في دار العجزة، يعاني من عقوق الأولاد والخرف وتنكر الزمن، مثل أم أجبرتها زوجة الابن أن تدفن حياتها مبكراً في مأوى للمسنات بعيداً عن أحفادها وجاراتها والناس، مثل أخ كبير، كبّر اخوانه، وضحى من أجلهم ولهم، فرّق ماله وحاله عليهم، وحين كبر وشلّ لم يجد من الأخوة لا عضيداً ولا سنيداً، إلا أختاً وحيدة تظل تبكيه بصدق قلبها حين ترى ارتجافاته، ودمعة باردة تسكن طرف عينه، مثل ابن يزين لنسائه صحن الدار، وينسى حليب أمه، وينسى فضلها وكل خيرها، ويسكّنها على السطح أو في مرفق أعده المهندس ليكون مكاناً للغسيل أو مستراحاً لخادمة المنزل! كيف تنسى المدينة رجلاً عمل لها وخدمها بماء عينه، وهو اليوم في كبره تلفظه بيوتها، ويعيش بأجرة في ملحق بيت شعبي مثل أي عامل طارئ على المدينة؟ كيف برجال عاشوا زمن الفاقة والتعب والخوف والتأسيس، وهم اليوم في تقاعدهم القديم يعدون أمورهم بالفلس، لكي لا يمدوا أيديهم، يدخلون السوق ببضائع لا تليق باسمهم وتخجل منها رتبهم، فقط لكي لا تنكسر نظرة أعينهم في عمرهم المتبقي؟
ثلاثة أمور تزلزل القلب، دمعة طفل، وانكسار رجل مسن، وحاجة امرأة عجوز!
GMT 22:31 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
كبير الجلادينGMT 22:30 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
التغيير في سورية... تغيير التوازن الإقليميGMT 22:29 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
أحاديث الأكلات والذكرياتGMT 22:29 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
هل مع الفيروس الجديد سيعود الإغلاق؟GMT 22:28 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
سوريا... والهستيرياGMT 22:28 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
لا يطمئن السوريّين إلّا... وطنيّتهم السوريّةGMT 22:27 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
هيثم المالح وإليسا... بلا حدود!GMT 22:26 2025 الخميس ,09 كانون الثاني / يناير
جرعة تفاؤل!صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©