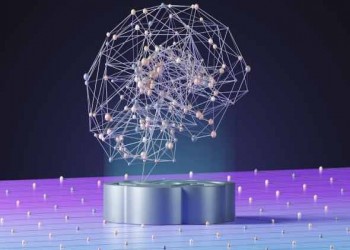الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
سادن الدار البيضاء
سادن الدار البيضاء

ناصر الظاهري
توفي سادن الدار البيضاء، وأحد حرَّاس أبوابها، توفي الطيب الصدّيقي، تاركاً مدينته تضج بناسها، وأوجاعها، وتتمدد على نفقة عشاقها، ومن رأى الطيب الصديقي يجوس في تلك المدينة، وحبوسها، ودرب السلطان، ويعرف أين يسكن الفقراء، وأين يمكنه أن يقبض على صعاليكها، ودراويشها، يدرك أن له حضوراً في المكان، وحين جلت معه مرة في أزقتها، وأماكن الفرح فيها، مرتدياً عباءته السوداء المبخرة بالعود، وكحل يخط العين، تاركاً لحيته وشعره الطويل المخضب بالسواد والبياض، وسيكار لم يتخل عنه طوال حياته، متعكزاً على عصا، يقول إن له فيها مآرب أخرى، قلت له: أشعرتني أنك عمدة كازا، فرد بصوته المسرحي الجهوري، قدمت لها الكثير، وقدمت لي الكثير، فحق علينا أن نتحابا، ونمضيا بعشقنا للتوحد الصوفي.
فرضت مستجدات الحياة ذلك البعد، فالجغرافيا لها نصيبها حين تستقر به في نهايات الشمال، ولا يجرب هو الريح ومراكبها، وتباعدك أنت في مسافات الجنوب، ولا تكل من ترحال كطائر وهب جناحيه للريح والمدى، ثم أن هناك شخصيات تفضل أن لا ترى شيخوختها التي تشبه رماد الخريف، وهو الذي كان كحل العين.
كنت التقيت به لأول مرة في بداية التسعين في دارته الجميلة، وترحاب زوجته الأجمل، كانت أمسية أخرجها مسرحياً كيفما يشتهي، ضمتنا مع الصديق السعودي المرحوم صالح العزاز، وحسن العلوي حاكم فريموس، وأحد المسرحيين، كانت سهرة ثقافية ممتعة، ونقاشية ساخنة، تخللتها موسيقى، وأطايب الدار، تجادلنا في تفسير سورة الكوثر، واختلفنا على زيارة «رابين» لبيته، كان التاريخ والمسرح والسينما، ومدن الحرية والنور هناك، ويوم عيد ميلاده أحضرنا باقة ورد لا تدخل من باب البيت، كانت تعجبه الحركات المسرحية، وهو الذي ابتكر مسرحاً مغربياً جديداً، كان طلقاً، وفي الأسواق، وساحة جامع الفنا بمراكش، جذب المغنيين في الأحياء الفقيرة، وقدمهم للناس، كفرقة «ناس الغيوان»، وجل جلاله، اعتمد على التراث والإرث العربي، كمقامات عبد البديع الهمذاني، وخالط بين العربية والدارجة المغربية، كان مقلاً في السينما، له فيلم «الزفت»، ودوره المميز، للوليد بن عتبه في فيلم «الرسالة»، لكنه ظل يشككني أنه هو، حتى كدت اقتنع بكلامه.
كان وقتها يجرب العمل الفني البدائي للإنسان على الخزف والفخار، ويزينه بالخط العربي أو الحروف الأمازيغية، وأهداني جرتين.
بين «الصويرة» تلك المدينة التي ولد فيها الطيب ابن رجل العلم والدين إلى الدار البيضاء، حيث أضواء المسرح والشهرة، ومحاولة اكتمال نضج معرفة الإنسان، مضت تسع وسبعون سنة مما يعدون، لكنها أَرَّخت لهذا الفنان الكبير.. لروحه السكينة والطمأنينة، والحب المشفوع بالصلوات.
GMT 20:13 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
ترتيبات استقبال الإمبراطور العائدGMT 20:12 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
هل مسلحو سوريا سلفيون؟GMT 20:11 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
أزمة الغرب الخانقة تحيي استثماراته في الشرق الأوسط!GMT 20:11 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
القرضاوي... خطر العبور في الزحام!GMT 20:10 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
مخاطر الهزل في توقيت لبناني مصيريGMT 20:09 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
لعنة الملكة كليوباتراGMT 20:09 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
الحرب على غزة وخطة اليوم التاليGMT 20:08 2025 الجمعة ,10 كانون الثاني / يناير
نحن نريد «سايكس ــ بيكو»صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©