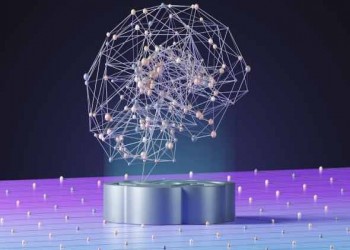الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
المبدعون.. شهود وشواهد العصر
المبدعون.. شهود وشواهد العصر

بقلم : ناصر الظاهري
في معرض فرانكفورت للكتاب، تحدثت مرة عن قضايا تكريم المبدع من خلال الجوائز المحلية والعالمية، وأثرها على إنتاجه وشهرته، وحينما تطرقت لنوعية التكريم الذي يحظى به المبدع العربي في بلده الصغير أو وطنه الكبير، حيث لا اهتمام به يذكره في حياته، وحين مماته، قد يبنى له تمثال أو يهتم به لأن بلداً أجنبياً تبنى تخليده لأثره في الأدب والثقافة الإنسانية، كان الجمهور الأوروبي والألماني بالذات ينظر إليّ، وكأنه يستذكر شيئاً من ماضيه القديم أو يحاول أن يجد لنا مبرراً واحداً على هذا التصرف والجحود، كانت الدهشة تعقد ألسنتهم حين يعرفون أن على المبدعين العرب أن يدفعوا ضريبة الجوائز التي ينالونها من قبل مكرميهم سواء حكومات أو أنظمة أو أحزاب، ولا يعطون للمبدع حرية أن يكون صادقاً مع نفسه وموضوعياً مع ذاته، فيضطر للهجرة الاختيارية أو المنفى الإجباري.
أن تقدم للمبدع باقة ورد من توليب يسقيها بيده، ويعرف لونها، وتفرح قلبه، يضعها عند شبّاكه أو شرفة منزله، خير من ورود بنفسجية يضعها الآخر على شاهد قبره البارد.
كلمة شكر ليست كثيرة على المبدع، لأنه طالما حمل صليبه على ظهره، وأثقله بعذابات الناس وآلامهم وآمالهم.
أحياناً كلمات قليلة تسوّر بها عنق المبدع، لكنه يدفع عنقه ثمناً لها، وثمناً للشرف حين يكون الشرف جزءاً من كلمات الرجال.
من كان يعرف المتنبي حين يغشاه الليل؟ وحين يريد إظهار كرم القلب واليد، فلا يجد إلا ضيق الصدر، وضيق ذات اليد؟ فينكسر لوحده في ظلمة ذلك الليل، وحده النهار كان يرينا المتنبي وهو يتعالى كعادته على كل الأشياء، دافعاً ضريبة شهرته، وتلك الرنّة الثقيلة لاسمه حين يحضر اسمه، وتختفي كل الأسماء.
سقراط كان بإمكانه أن لا يذهب باتجاه السم، لأنه يعرف صنعته، ومسميات تراكيبه، لكنه كان يريد أن يعطي تلامذته درساً أخيراً، ما داموا مقبلين على الحياة بعقل ساخن، وقلب بارد، ولا يحبون أن تتساوى الأمور عندهم.
كم عدد سكان الصين، كم تكاثروا وتناسلوا وتقاتلوا وعمروا وهاجروا.. وحده كونفيشيوس العظيم ظل كطائر لا يغيب عن سماء الصين.
كم من تاجر في عصر شكسبير، كم من مراب، كم من حداد وسائس للخيل، كم من مداهن للبلاط، كم كان عدد الحاشية؟ لماذا شكسبير وحده ظل تاجاً من نور في تلك الإمبراطورية المشمسة قديماً؟
GMT 22:32 2016 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر
خميسياتGMT 21:24 2016 الأربعاء ,07 كانون الأول / ديسمبر
التنسك في الألوانGMT 21:19 2016 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر
نوبل.. تلك النافذة الكبيرةGMT 23:31 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر
السماحة تميزهم.. ولا تغيرهمGMT 21:21 2016 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر
نتذكر ونقول: شكراًصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©