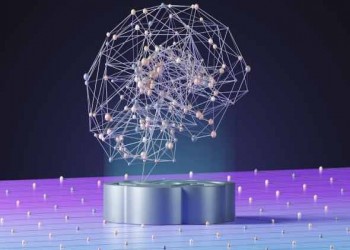الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
تذكرة وحقيبة سفر -1-
تذكرة وحقيبة سفر -1-

ناصر الظاهري
بقلم - ناصر الظاهري
السفر مع الكتّاب والأدباء والفنانين ممتع للغاية، ولكن عليه تبعات، وضريبة يجب أن تدفعها، وعليك كذلك أن تلتزم بقواعد تجبر نفسك عليها، أولاها تحمل ذاك المزاج المتقلب، لا تغضب إذا تأخر أحدهم بالساعات، لا تحاول أن تنتظر أحدهم أكثر من عشر دقائق، عليك أن تكون محتاطاً مالياً بمحفظة منتفخة لا تفارق جيبك، لأنه أمر عادي، ويحدث دائماً أن يخرج أحدهم وجيبه خال من المال، ويطلب الأكل والشراب الغالي، وهو «خبر خير»، طبعاً معظمهم لا يحملون بطاقات ائتمانية، وإذا كانت عنده، ستجده نسيها في الفندق، ورغم ذلك فالسفر معهم يزيدك معرفة، ويبَصرك بمتعة كانت غائبة عنك، ويزودك بتجربة حياتية مهمة، ويكسبك أصدقاء جدداً، لهم طقوسهم وحياتهم، ولهم حضورهم المميز.
لذا.. عليك خوض تجربة السفر، برفقة أدباء وكتّاب وفنانين، خاصة في مدينة استثنائية مثل باريس، بحيث تجد كل واحد يبحث عن مبتغاه، وفي ذهنه صور متخيلة عن المدينة، وروائح أمكنتها، وعن أبطال روايات، وقامات شعراء، ورسامين لونوا جدران المدينة، وغابوا تاركين ظلالهم وقصص فرحهم وشقائهم، تلك الرحلة التي ضمتنا في شتاء باريس القارس مرة، وسقوط ثلوجها المرحة والمشاغبة، كنّا سعداء بمنجز ثقافي في معرض باريس للكتاب بترجمة أدب الإمارات للفرنسية، غير أن المدينة استطاعت أن تسحب القادمين الجدد، والمترددين، وحتى المخلصين لها، ولشوارعها العامرة بالفن والثقافة وجمال العمارة، وكل ذلك الشقاء المطروح على جنبات طرقها، بعضها مختار، وبدافع الحرية المطلقة للإنسان، والمتحررة حتى من جدران المنازل، وبعضها الآخر أجبرتهم عليه الحياة، وقسوة ظروفها، تنازعت المدينة أجنحة الشعراء، وخطوات أقدام الروائيين، تقودهم الدهشة حين تتهامل مثل أسئلة جميلة لا تحبها أن تنقطع، ولا تريد أن تبحث لها عن إجابة، ويقودهم مطر الليل، ونواح «ساكسفون» وصدى لصوت «اديث بياف» تسرّبه أبواب المقاهي التي تشبه بيوت الجيران من دفئها وحميميتها، منهم من قصد «نوتردام» يبحث عن أحدبها، وينصت لذلك الجرس الخرافي الذي تحمله تلك الكنيسة في قفص صدرها، ومنهم من حاذى شارع «أميل زولا» أو ساحة «فيكتور هيجو»، متتبعاً أثر أبطال روايات وقصص طالما أشعلت ذاكرة الطفولة والقراءات المبكرة، وظلوا في قاع الذاكرة، واليوم يقومون من سحبهم الزرقاء التي كانت في الرأس، ومن أصدقاء الرحلة مَن تعنى قاصداً «ساحة مونمارتر» حيث اللون هو الطاغي، والفرشاة المبللة بتعب العرق، ورجفة الأصابع، وما يجلبه العنب معصوراً حين يسكن في قارورة مغبَرّة في حقيبة جلدية لرسام، وضع كل المدينة وتفاصيلها في تلك الحقيبة، وما زال يمشي ويبكي ويغني، هناك.. في ذلك المكان الذي تعرت أشجاره، ولمعت أحجاره القديمة ضاع الأصدقاء، وبحث كل عن لوحته المفقودة، ولونه الضائع، أصدقاء الرحلة الصعاليك ممن يعرفون أماكن التنوير في المدينة، وضجيجها الثقافي، ذهبوا للحي اللاتيني، ولَم يفوتوا عرض مسرح «أوشيت»، حيث تعرض مسرحيتا «المغنية الصلعاء» و«الدرس» منذ سبعين عاماً ويزيد، وليتلذذوا بطعام تقليدي بعد العرض المسرحي من «الفاندو» أو «الكريك»، متسكعين في ليل ذاك الحي الذي عرفه جلهم من رواية «سهيل أدريس» «الحي اللاتيني»، أما النخبويون من الأصدقاء فكان متحف «اللوفر» وبيت المثّال «رودان» ومتاحف باريس هي ملاذهم في تلك الرحلة التي مضت أيامها متسارعة دون أن ندري.. وغداً نكمل.
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©