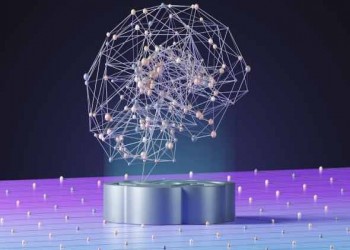الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
تذكرة.. وحقيبة سفر 1-
تذكرة.. وحقيبة سفر 1-

ناصر الظاهري
في النصف الثاني من الثمانين، قيض لي أن أسافر إلى اليمن كصحفي ضمن وفد رسمي، وسائح، يسبقني فرح لرؤية أمر كان يأتي من حكايات الكتب، وأحلام يسربها لنا ذاك الخافق الذي ينشد دوماً ألقاً، ووهجاً، عربياً، هي صنعاء إذاً، ولو طال السفر، ولو كانت على مرمى حجر، غير أنه لا أجمل من تلك الفرص التي تدق بابك بعنف، وتقول: تزود، فإن السفر قريب، كانت تلك الرحلة دعوة لحضور مناورة «الفجر»، أما لي فإنها المصافحة الأولى لذلك البلد، لذا قلت لهم: دعوني أهيم هنا، واتركوني، سافر الوفد، وبقيت سائحاً، لأن تلك التربة التاريخية تعني لي شيئاً كثيراً، وتلك الوجوه المنّسلة من حقب الدهر البعيد، تعني لي شيئاً كبيراً، لا يمكن أن أرى تلك المباني العوالي، الرابضة على قمم الحجر أو تلك البيوت التي تسكن الجبل، ولا أقف مشدوهاً، أراجع كتب التاريخ، وأتعلم، لا يمكن أن أرى مرتفعات إبّ الخضراء التي تريد أن تقطف الغيم، ولا أتوقف متأملاً، وأتفكر، كانت أبواب صنعاء تستوقفني، وتقول لي: من هنا سلك واحد مثلك أو يكاد يشبهك أو هو شيء من روحك، وتركناه يمر، كان سوق الملح، وجلبة أولئك التجار القدامى، شبيهاً بأسواق الجاهلية الأولى، ورحلة الشتاء والصيف، ثمة شيء من غبرة، وعفرة تغشى الوجوه، وتقول: لقد توقف الزمن هنا.
دخلت صنعاء متهيباً خوف أن تغلبني بحبها، دخلتها وجلاً لكي لا أضيع في دروبها، ولا أجد نفسي، كانت الأيام الأولى التي تلزمك بالرسمية وبملابسها الثقال، وبالتحرك الذي يمنطقك فلا تأخذ خطواتك مداها، ولا تتعفر قدماك بتربتها، كنت أريد أن تكتحل عيناي بكل تلك السموات غير البعيدة، أن أطوق اليمن من بحرها وبرها وجبلها، ولا تفوتني فائتة، ولا تشرد مني شاردة.
حضرت مناورة «الفجر» في سبأ بعد أن قطعت بنا سيارات عسكرية طرقاً يتساوى معها الرمل والحجر، والصاعدة والهاوية، ذكرتني بالطرق الوعرة التي كان يسلكها «الجيب غير المطربل» ونحن صغار، ذاهبين إلى أبوظبي أو راجعين من العين، أو صيفاً حين نبغي عُمان للمقيظ، طرق حضرت في ذاك الصباح المبكر، والمتربة ريحه، مع مهارة منقوصة، ومشكوك فيها من طرفنا لذلك السائق الذي كان يكن عداء متجذراً لتلك السيارة، ويعاملها كخردة غير مستردة، كنت لا أشك أن بصره حاد، لكن ليس في مثل تلك الدوامات الشيطانية، تم يغلينا، ولا أحد يتلقفنا.. ونتابع غداً
GMT 19:41 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
أزمات إقليمية جديدةGMT 19:23 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
قيصر روسيا... غمزات من فالدايGMT 19:19 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
المفهوم الايراني للانتخابات... والعراق ولبنانGMT 19:14 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
رسالة مناخية ملهمة للعالمGMT 23:17 2021 الخميس ,10 حزيران / يونيو
ظهورُ الشيوعيّةِ في لبنانصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©