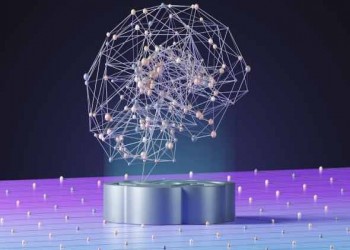الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
تذكرة.. وحقيبة سفر (2)
تذكرة.. وحقيبة سفر (2)

بقلم : ناصر الظاهري
بعد تلك الوجبة البحرية المغربية التي شغّلت كل حواسي- كعادتي- قبل أن أتذوق أي أكلة، لكن هذه المرّة، لا أدري لماذا عطّلت كل حواسي، وهجمت أفكك عظامها؟ بقيت يداي تتحسسان وجهي من حين لحين، أخاف في لحظة غفلة مني أن ينتفش، ويغدو أشبه بالإنسان الأول أو «أورنج أوتان».
من يومها زاد نفوري من السمك، وأطايب البحر، وثماره، وفواكهه، كما يسميها الفرنسيون، بعد ثلاثة أيام من حادثة التسمم، دعاني وزير الثقافة المغربي حينذاك الصديق «محمد الأشعري»، لوجبة غداء، وأراد أن يفاجئني، ويكرمني بوجبة سمك معتبرة، في مطعم لا يقدم إلا الأكلات البحرية، وما إن رأيت «الحوت» -على رأيهم- وتلك الكائنات المائية التي يمكن أن تمشي في غفلة منك، وتخرج من صحونها حتى اقشعر جلدي، وكدت أن أصاب بعدوى التسمم نفسياً، وعن بُعد، فشرحت للوزير قصتي مع حوت المغرب، فبدا على موظف العلاقات العامة بعض الحرج، وأراد أن يعتذر فجأة، فالوزير أراد أن يكرمني بوجبة سمك مثل تلك التي ذاقها في أبوظبي قبل سنوات، حينما أخذته إلى مطعم «أبو طافش» حين كان حيّاً يرزق على البحر، ومن البحر، ويومها شعرت أن ضيفي لا يريد أن يشبع من السمك عندنا، ولكنه تعب قليلاً، ويريد أن يستريح للمعاودة من جديد.
ظل هاجس الانتفاخ المفاجئ يسيطر عليّ، وأحياناً يأتي كحلم «فانتازي»، فساكنت النفس، وبقيت إنساناً آخر، بدأ يتذوق اللبن الرائب، وعصائر الفواكه المبروشة، ويشرب الماء الفاتر، وبدلاً من فطور الحاجة سعدية: «مسمّن وبغرير وزبدة وعسل»، وكأنها تعمله لابنها الغائب خلف البحر، وتنتظر عودته من مهجر انتقائي، أصبح فطوري، فطور تلميذ وحيد والدته أرستقراطية، حبوب، ونخالة، وأشياء ذائبة في الحليب، لا تدري من أي غصن قطعت أو أي شجرة نبتت، لكن هذا الحال لا يستطيب لشخص مثلي يحب أن يشق شوارع المدن كعتّاليها، يبحث عن أشياء ضائعة، ومخفيّة، وأشياء جديرة بالتأمل والقراءة، ووجوه يريد أن يثبّت حركة الزمن عليها، يقلّب عدسة «كاميرته» ذات اليمين، وذات الشمال، يراوح بين يديه لثقلها، والتي يتمنى أن لا يغيرها الزمن ذات يوم، بعصا يتوكأ عليها، ويهشّ بها عن غنمه، وله فيها مآرب أخرى.
قررت أن أداويها بالتي كانت هي الداء، وأن أكسر الشر، أو أُحَيّد العين - على رأي سهيلة- وبعد أيام معدودات جلست على ضفة أخرى من البحر الأبيض المتوسط، أتناول سمكاً في مطعم تونسي، متفرد كنسر هرم، والبحر قدامي!
GMT 22:32 2016 الخميس ,08 كانون الأول / ديسمبر
خميسياتGMT 21:24 2016 الأربعاء ,07 كانون الأول / ديسمبر
التنسك في الألوانGMT 21:19 2016 الأحد ,04 كانون الأول / ديسمبر
نوبل.. تلك النافذة الكبيرةGMT 23:31 2016 الخميس ,01 كانون الأول / ديسمبر
السماحة تميزهم.. ولا تغيرهمGMT 21:21 2016 الثلاثاء ,29 تشرين الثاني / نوفمبر
نتذكر ونقول: شكراًصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©