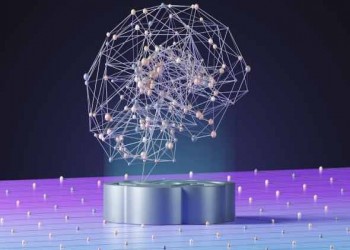الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الضحكة الغائبة كحُرقة العطش
الضحكة الغائبة كحُرقة العطش

بقلم : ناصر الظاهري
لماذا حين يلتقي الأصدقاء القدماء، أصدقاء المنازل الأولى، حيث الطين والرمل والماء وَالنَّخْل، والأبواب المشرعة منذ الفجر، وحتى الليل وهدأته وصوت السكون، أصدقاء الصفوف الأولى، زملاء المقاعد المدرسية الخشبية، رفقاء السنوات الدراسية، وملاعب الصبا، قرناء الخير والشر، الأتراب، إخوان الطفولة المبكرة، والشباب الغض، وعمر الدهشة والاكتشافات الأولية لكل الأشياء، وأمور الحياة، لماذا حين تلقاهم مصادفة أو يجمعكم عرس، تظهر فجأة الضحكة الغائبة؟ لماذا يتصاعد دم الفرح في الوجه، وتشعر بأن معدل «الأدرينالين» قد ارتفع، جاعلاً نشاطاً فجأة يسري في كل أطراف جسدك؟ لماذا تشعر بأنك بخير، ولا شيء من هواجس العمر والجسد، إلا الحمد والشكر، واللذان يترادفان مع تلك الضحكة الخارجة من القلب، مثل رغيف ساخن ساعة شتاء ومطر؟
هل هي الأشياء المشتركة التي جمعها سير العمر؟ أم هو ما رافقها من ضحك وجنون ولعب، حيث لا حسد، ولا ضغينة تسكن النفس، ولا شيء غير تلك العفوية والفطرة التي تقود خطانا نحو البراءة الكاملة؟
الأعراس هي جالبة ضحكة الأولين الغائبة أو التي تسترها الدنيا الْيَوْمَ، ولا أحد يدري ما هو السبب، فجأة كبرنا، والذي كنّا نحطب له الحطب في عرسه، ونفزع معه ذاك الْيَوْمَ، ها هو ابنه الْيَوْمَ معرس أو أن ابنته التي كنّا تمنينا لها ولزوجها العام الفارط أن يكون منه المال، ومنها العيال، ها هي تزف له بشارة بأنه أصبح جداً، وعليه أن يحُضّر من الآن مسبحته، وعكازته، كنّا وما زلنا نحن الحضور والشهود، ولكن مع سنوات زائدة، ومسؤوليات نُكبّرها، فتكبر على رؤوسنا، وغياب تلك الضحكة التي كانت ترّن في الأذن.
«مساكين جيل الخمسين والستين والسبعين»، هم الطيبة الباقية، والأمانة والصدق كما هما، وهم زينة هذه الأيام بعد ما ودعنا رجال من وقت وتعب، رجال ونساء لن يتكرروا، كانوا مثل قناديل في تلك البيوت الكبيرة الواسعة، كمركض فرس، كانوا دفئها، وكانوا عطرها، لم يبق منهم الْيَوْمَ الكثير.. الكثير، فقد تناسلوا مثل سبحة صلاة، وفِي غفلة عنا ومنا، محاولين بقدر ما تسمح به تلة الطيبة الباقية سمة أهل الدار، أن نكون مثلهم أو دونهم أو نحلّ محلهم، لكن الوقت غير الوقت، والنَّاس ما عادوا مثل الناس.. لذا تغيب عن محيا جيل الخمسين والستين والسبعين تلك الضحكة الأولى، الذاهبة نحو البراءة المطلقة، حتى تحضر فجأة، إذا ما ضمهم مجلس أو جمعهم عرس، وتلاقوا يخفون بياضاً غزا الرؤوس، لا يودونه أن يخرج من ستره، متعكزين على صبر الأولين، وما إن تتلاقى العيون حتى تستبشر الوجوه، وتخرج تلك الضحكة الغائبة منهم وعنهم، والتي لها رنين في الأذن، وتسعد النفس كشربة ماء بارد ساعة حرقة العطش!
GMT 09:11 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
أحلام قطرية – تركية لم تتحققGMT 09:06 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
تذكرة.. وحقيبة سفر- 1GMT 09:03 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
عندما تصادف شخصًا ماGMT 08:58 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
اختبار الحرية الصعب!GMT 00:41 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
وماذا عن الشيعة المستقلين؟ وماذا عن الشيعة المستقلين؟صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©