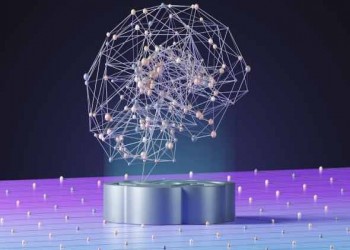الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
تذكرة.. وحقيبة سفر - 1
تذكرة.. وحقيبة سفر - 1

بقلم - ناصر الظاهري
ذات صيف لن يتكرر، بحلوه الذي أتمناه، وبشره الذي لا أتمنى، كان في عام التسعين، وبدايات العمل الصحفي بعد التخرج، اخترت لأكون مرافقاً إعلامياً لمنتخب كرة السلة العسكري في رحلته التدريبية، ومشاركاته الخارجية لبطولات «السيزم» التي ستقام في فرنسا، وكان خط الرحلة يوغوسلافيا، العراق، فرنسا، كانت رحلة ستستمر قرابة الشهر ونصف في ذلك الصيف البارد، والذي تحول فجأة إلى صيف من نار، حين بكرنا على أخبار دخول الدبابات العراقية أرض الكويت، فجأة تخربط كل شيء، وتغير إيقاع مدن العالم، وفارت النفوس، كنا حينها في جمهورية يوغوسلافيا الاشتراكية الاتحادية، نتنقل في تلك الجمهوريات الست، «صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، ومقدونيا» التي وحّدها «تيتو»، وعاشت على حسه، ولم يكن يطرأ على البال أنها ستذوق ويلات الحرب والتفكك والحرب الأهلية والإقصائية والإبادات البشرية، بعد عامين من ذلك الصيف، كانت يومها هادئة، والناس ربما لم يكونوا في خير، لكن راحة السلم، ورائحة الأمان تسكن في النفوس، غيّرنا وجهتنا إلى العراق في أغسطس ذاك الصيف، واستقر بنا الحال في سراييفو.
ومن لم يعرف سراييفو قبل الحرب، فلن يعرفها أبداً، مدينة معفرة بتربة التاريخ، جبال معممة بنضارة ألوان الحياة الريّانة، وأنهرها من الجنة منسابة، بتلك الزرقة المتماهية بالخضرة، والتي تسقي الحجر الثقال، المساجد الممهورة بمئات السنين، وعرق الأتقياء، الأزقة الملتوية تحضن الحجر والقرميد والشبابيك التي تعشق شمس النهار، ونفة المطر، وصبايا يغزلن الوقت من أجل الأحلام.
«سراييفو» تذكرك بتجار الحرير والسجاد، وخان زمان، المطاعم العائلية في «باشرشيا» التي لا تقدم غير خبزة ساخنة خارجة لتوها من التنور، وقضبان لحم مشوي على الحطب، بطريقة بدائية غير بعيدة عن تركيا واليونان وقرى الشام ولبنان، الساحة البلدية، وماء السبيل، وحمائم ترفرف تضفي على الساحة نوعاً من بهجة الحياة، وجوه تعتقد للوهلة الأولى أن الزمان نسيها أو هي فرت من ذاك الزمان، الصبايا الفارعات، كحور من الجنان، تدثرهن الحشمة ومسحة التقوى، وذاك البياض الذي ينبئ بالعافية، وتلاقح السلالات، تحلف أنهن مختلفات عن ما رأت العين في بلاد الله، تتيقن أن القبح لا يسكن في هذا المكان، وأن الإسلام الذي جاء إلى هنا على وقع سنابك الخيل والخير، ومد الانتصارات، جلب أشياء كثيرة من مدن كثيرة، ورماها في حضن «سراييفو» مرة واحدة.
سراييفو جبال لها بياض النهار وثلجه في شتاءاتها المرجفة، والخضرة الوافرة في ربيعها وصيفها الذي لا ينسى، وكيف تنسى، ومرة يأتيك مخضباً بمطر خفيف، ومرة مكللاً بظل رفيف، ومرات بصباحات لها محيّا سكون المؤمنين، وهدأة نفوسهم، ألق للمكان يبكيك حد الوجع، وحد تذكر أزمنة فائتة من العمر، أزمنة لها رائحة سمرقند، وعطور بخارى الليلية، ونشوة فرغانة، وأشياء ساكنة في طشقند.. وغداً نكمل..
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©