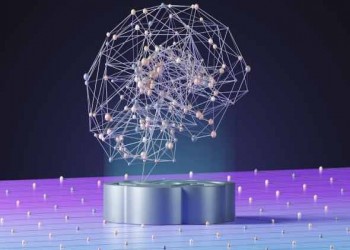الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
تذكرة.. وحقيبة سفر
تذكرة.. وحقيبة سفر

ناصر الظاهري
في بداية السكن والاستقرار في فرنسا، وحين كانت اللغة فرخاً صغيراً يحبو، كنت أدخل رأسي في تفاصيل اليوم للعلم بالأشياء، واكتساب المهارات اللغوية أو حتى الأمور الحضارية، خاصة إن كان الإنسان يريد أن يقرأ أدب هذا الشعب وقصصه ورواياته، لذلك كنت أكثر من فعل الخير، وهي طبيعة بشرية ورثتها من الأشياء الجميلة المشتركة التي كنت أرى فيها الأب والأم وهما يفرحان إن قدما شيئاً، فبقيت في الرأس أو جاءت عن طريق الأنزيمات لا أعرف، وهي كذلك صفة حضارية مكتسبة من القراءات والمشاهدات وبناء الشخصية، لكنها كثرت أكثر من اللازم في تلك الزيارات الجميلة التي لا تعرف الزمن ولا الوقت الذي يجري خلفك، اليوم أتحسر عليها!
ولعل الفضول وربما الشغف القصصي زاداها أيضاً، فكنت أفسح دائماً للقادم أمامي أو أحاول أن ألقي عليه التحية والسلام ولو بإيماءة من ضحك العيون أو أساعد عجوزاً على عبور الطريق حتى أقعده على مقعد الحديقة أو أتبرع بتقديم الفكة ممن يطلبها ولا يجدها في صندوق المحل الذي أكون موجوداً فيه بالصدفة، وأحياناً أقف لسماع موسيقّي يعزف في محطة القطار، ولا يتنبه له الكثيرون أو يمرون مسرعين من أمامه، ولا أنسى أن أنقده بعض المال مع تصفيقة خفيفة أو إيماءة من الرأس تدل على الامتنان أو أجالس بعضاً من كبار السن والمتقاعدين من الجزائريين أو المغاربة ممن شاركوا في حروب فرنسا خارج مياهها الإقليمية أو أجلس أنصت لحديث العجائز «اليمينيات»، وهن يكلّن السباب والشتائم على الملونين والعرب في فرنسا والمهاجرين الأفارقة، حتى أحياناً أسمع شتائمهن تكاد تصل إلى كرسيّ الجالس عليه مع أنيسي الكتاب أو الصحيفة، كان من الفرح أن أقدم تذكرة «الـمترو» برحابة صدر إلى امرأة أفريقية مرتبكة بوزنها وأثوابها الملونة، وعمامة رأسها، ولكنتها الأفريقية التي تشبه بهاراتهم الساخنة النافذة أو أخفف من حاجة مغاربية بثيابها البيضاء، ولثام الستر على وجهها، والخوف من الأشياء التي لم تعتدها، أحس وكأنها دائماً مثل الأم التي تبحث عن ولدها الغائب الوحيد، والذي لا تعرف عنوانه، فأشفق عليها وأساعدها للوصول إلى مبتغاها.
كنت أفعل كل تلك الأمور بشيء من الحبور والفرح معتبراً إياها جزءاً من تفاصيل أعشقها من، وفي الشارع، لكن هناك جبروتاً للزمن كيف يقدر أن يسرق منك فضول وبساطة الماضي، وكيف يعمل على تخشبك، ويزيد من تربصك، وشكك في الأشياء والناس، وأنك لم تعد ذلك الإنسان الآخر الذي ربما لا تعرفه اليوم!
GMT 19:41 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
أزمات إقليمية جديدةGMT 19:23 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
قيصر روسيا... غمزات من فالدايGMT 19:19 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
المفهوم الايراني للانتخابات... والعراق ولبنانGMT 19:14 2021 الأربعاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر
رسالة مناخية ملهمة للعالمGMT 23:17 2021 الخميس ,10 حزيران / يونيو
ظهورُ الشيوعيّةِ في لبنانصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©