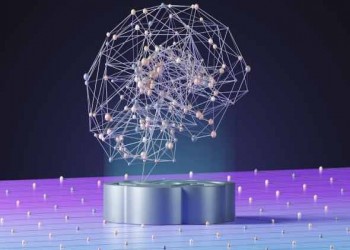الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
يليق به.. وله الكثير
يليق به.. وله الكثير

بقلم : ناصر الظاهري
هكذا هو مقام العظماء عند الشعوب والأمم، مقام لا يسمو إليه كل أحد، ولا يناله إلا المجتهد الصابر، والكريم البار بشعبه وبلده، فالعظماء يبقون شهوداً على حاضر الوطن ومستقبله، وإنْ غابت أجسادهم في ثراه، يطلون علينا من خلال تسمية شارع وجامعة وصرح ثقافي ومعلم حضاري أو يزينون الساحات العامة بنصبهم التذكارية التي تخلد حضورهم في ذاكرة من سيأتي، ومن ينعم وسينعم بما صنعوا وشادوا وخططوا، فالأوطان لا تنسى روادها ولا حرّاسها، ولا باعثي النهضة فيها، وإنْ جفت بعض أوراق وأحبار التاريخ يوماً، فسيأتي من يبعث الوهج والنور حولها وفيها، وحده التاريخ مأوى لأسماء العظماء والشرفاء والفرسان والشهداء، ومن كانوا يعرفون معنى النبل.
كنت قد ناديت قبل سنوات بأن تحظى العاصمة بنصب للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان، طيّب الله ثراه، وجزاه عنا وعن الوطن خير الجزاء، تقديراً لما عمل وصنع لهذا الوطن، وعرفاناً بما قدم لأمته العربية والإسلامية، وللإنسانية جمعاء، فقد كان مثالاً للإنسان النبيل، لا يفرق بين أحد، ولا بين دين وملّة، ولا بين صديق وشقيق، ولا بين غريب وقريب، كان يجسد الفروسية في أبهى حللها، ويمثل الصدق في أدق معانيه، فَلِم لا تظل ذكراه باقية على الدوام في أوقات يومنا، كما هي عطرة في نفوسنا، وذلك من خلال إقامة نصب تذكاري يكون شاهداً على الوقت، وأمام أعين من سار أو أتى، ويكون نبراساً يزين جبين العاصمة، ومثالاً يتراءى للأجيال الجديدة التي تشهد مكتسبات، وتجني من مقدرات حافظ عليها الرجل، وضحى من أجلها، وصبر على ثمرها.
وفي يوم لم يكن بالبعيد، ولكنه من أيام الفرح التي تبهج النفس، وتجد في ذاك النهار مبتغاها وسعادتها، أرفق ابنه، شبهه وشبيهه، أن يقام للرجل العظيم نصب يليق بمقامه، ويسمو لمرتبته، ويفرح وطنه ومدينته، ساعتها اطمأن القلب، وكاد يطير من فرط النشوة، فالتذكر، وعدم النكران، وتقدير المعروف، والشكر، كلها تجعل دمعة العين تنزل سخينة، ولا تبرد من ساعتها، وليس كمثل دمعة عين بكت زايد، وبكت عليه.
GMT 09:11 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
أحلام قطرية – تركية لم تتحققGMT 09:06 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
تذكرة.. وحقيبة سفر- 1GMT 09:03 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
عندما تصادف شخصًا ماGMT 08:58 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
اختبار الحرية الصعب!GMT 00:41 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
وماذا عن الشيعة المستقلين؟ وماذا عن الشيعة المستقلين؟صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©