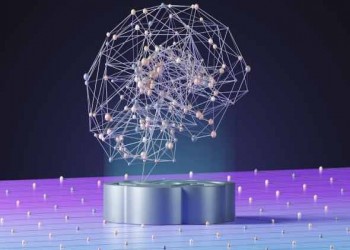الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
ليتهم ما تركوا الخيل تمضي
ليتهم ما تركوا الخيل تمضي

بقلم : ناصر الظاهري
ما أصعب ذلك الرحيل الذي يصطبغ بلون الرماد المحروق، وبسرعة خفقة جناح غراب، ضَل الخرابة التي ينعق فيها، فأتى بشؤمه مباغتاً، واستل من بيننا أفضلنا، ناثراً الحرقة في عيون الأصدقاء الذين كذّبوا ما سمعوا، وهالهم خبر النعي، فالرجل كان هنا بينهم، وكان يفكر معهم، ويحمل أوراق إبداعه، ويسأل عن هذا الذي سرقته الدنيا عنهم، وظل يحوم كطائر فقد ملاذه، وما عاد يُبين، ويعود ذاك الراقد على سرير الوجع في أرض الصير، ولا يود أن يعود، يخاتل ساعات النهار مرة مع صديقه «إبراهيم مبارك» متغلبين على ضجر ساعات التقاعد، فرحين بملكية الوقت، وفضاء المكان المطلق، ومرة يقضي تجواله الصباحي على إيقاع تفاصيل يعشقها، غير بعيد عن ساحل عجمان، وخيرات بحر الخليج، على مصطبات صيادين صلّوا فجرهم في البحر، وغبشوا برزقهم الحلال نحو المدن، ومرات يتبع ظله، وحده من يقوده لأماكن كأنها نحتت من أضلعه، ويعشقها مثل ماء عينيه، يجس أحوال أهله الأولين والباقين، روائح الأمس الجميل، ومن ظل عائشاً من رفاق عمه الشاعر «راشد الخضر»، وترانيمهم المبحوحة عن «خدَلجّ اللي خدّها كالسفرجل، وعن اللي إن بغت يَتّ بجماري»، تتداعى الأمكنة في رأسه، وتتخاطر عليه صور رجال قدّوا من صبر، ومن ضحكة لا تغيب، فيحمل آهته، ويحمّلها تجاويف الصدر، ويمضي موارباً دمع العين أن لا يسرق بهجة الصباح. هكذا كان «ناصر جبران» هنا.. وهنا.. قال صديق: قبل قليل حدثني، وقال آخر: تصورت معه «سلفي» قبل يومين حين صادف ولقيته، و«سناء» صديقة الجميع في اتحاد الكتّاب حادثها أمس عن مشروع ترجمة قصصه للفرنسية والبرتغالية، وأنها تنتظره كما ينتظره معرض الشارقة للكتاب مثل عادة كل عام، صديق آخر قال: ما زالت نكتته ترّن في أذني، وأن رقمه في هاتفي آخر المتصلين، ما أبشع ساعات الوداع التي بلا وداع، هكذا مضى «ناصر جبران» في غفلة من الجميع، مثلما كان يتساءل دائماً: «ماذا.. لو تَرَكُوا الخيل تمضي»؟
بالتأكيد كان لدى هذا الرجل النبيل والشريف أحلام معطرة باتجاه الوطن وناسه الطيبين، ولديه أقوال هي للأم وحدها، ولديه أعمال لم تنجز بعد، قبلات لأصدقاء وعد أن يطبعها على الخد، وأسفار شتوية مقبلة، وقراءات متراكمة، وأشياء تخص عشه وطيوره، وحديقة بيته وأعشابها غير المنجزة، فجأة قالوا لنا: «ناصر جبران السويدي» صلى صلاة الجمعة، وكأنها صلاة الوداع، وفارق الحياة!
GMT 09:11 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
أحلام قطرية – تركية لم تتحققGMT 09:06 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
تذكرة.. وحقيبة سفر- 1GMT 09:03 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
عندما تصادف شخصًا ماGMT 08:58 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
اختبار الحرية الصعب!GMT 00:41 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
وماذا عن الشيعة المستقلين؟ وماذا عن الشيعة المستقلين؟صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©