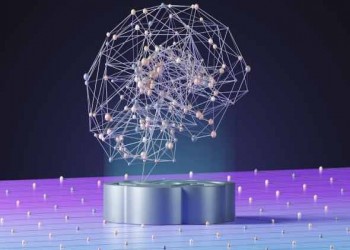الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
طريق الشر لا يؤدي لروما!
طريق الشر لا يؤدي لروما!

ناصر الظاهري
قابيل وهابيل.. تلك حكاية قديمة، كان الشاهد عليها غراب، وتكررت في كل الأماكن، وكل العصور، ولم يكن العاصم من الوقوع فيها مراراً وتكراراً غير تبحر الإنسان في العلم والمعرفة، وتحضر الإنسان وتمدنه، ونزول الأديان السماوية، والفلسفات الإنسانية التي هذبت من شراسته، ودفعته للعمل الإنساني الخيّر، ونبذ الشر ما استطاع.
ومنذ الصغر، وأنا أطرح سؤالاً على أساتذة التربية الإسلامية، والتاريخ، هل قتل الرسول محمد (ص) بيده إنساناً طوال حياته، وفي غزواته، وكذلك الأمر بالنسبة للمسيح عليه السلام، أما موسى عليه السلام فقصته مع القتل واردة في القرآن، غير أن لا مدرسي الدين ولا التاريخ قدروا أن يجزموا بشأن الموضوع.
بقيت أطرح سؤالاً مشابهاً بذلك لشخصيات أعرفها، ممن خبرت الحياة، وتبحرت في العلم والأدب، وقرأت الفلسفة، لكي أستشف مدى تغلغل حكاية قابيل وهابيل في النفس البشرية بعد كل هذه العصور، وحضارات التنوير.
وسألت نفسي في العشرين من العمر سؤال القتل، فكنت أميل إلى «أتغدى به قبل أن يتعشى بي»، وفي الأربعين، اختلفت إجابتي: «سأفكر، وأفكر، وربما قتلني، وأنا أفكر».
سؤال هل تقتل؟ لو يطرحه الإنسان على نفسه، ويكون صادقاً معها، كيف ستكون إجابة كل واحد منكم، هو سؤال فلسفي، وليس اختبارياً، سؤال للتأمل والتفكر، وليس لقياس ردة الفعل، ويفضل أن لا يُسأل ملاكم أو مصارع، أو تاجر مخدرات أو سائق شاحنة، جزء من مهمته التهريب، أو مجند «المارينز»، أو مرتزقة داعش والغبراء، هو سؤال للشعراء الإنسانيين، وليس لشعراء القبائل في جاهلية العرب، يمكن أن يطرح على الشاعر الروسي العظيم رسول حمزاتوف مثلاً، وليس على زميله ومواطنه بوشكين الذي خسر معركته بالسلاح، وخسر حياته كشاعر، يمكن أن يطرح على كاتب مثل «تولستوي» الذي هجر بيته هرباً من نكد زوجته، ولكي يبقى حراً وكاتباً، وتنازل عن إقطاعياته من أجل فقراء مزارعه، وإنسانيته، وليس على الكاتب الأميركي «همنجواي» الذي بدأ حياته ملاكماً، ثم متطوعاً في الحرب الأهلية الإسبانية، ثم متقاعداً في كوبا مع صديقه كاسترو، ومن ثم مات منتحراً، وورّث الانتحار لأولاده وأحفاده. يُسأل لموسيقار مثل بيتهوفن، وليس لعازف قربة أسكتلندي، يمكن طرحه على الزعيم «دلاي لاما»، وليس على زعيم الصرب «ميلوسيفيتش».
رسول المحبة والإنسانية ترتكب باسمه جرائم الكراهية، مثلما تفعل داعش، وتحلم أن يكون فتح روما قريباً، بعد ذبح الأقباط المصريين، وكأن كل الطرق تؤدي إلى روما!
GMT 14:52 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
مفكرة القرية: الإلمام والاختصاصGMT 14:51 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
الأشقاء السوريون!GMT 14:50 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
الجهاز الإدارى للدولةGMT 14:50 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
فيديوهات غبية في هواتفنا الذكية!GMT 14:49 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
إيران بين «طوفان» السنوار و«طوفان» الشرعGMT 14:48 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
عواقب النكران واللهو السياسي... مرة أخرىGMT 14:48 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
الهجوم الإخواني على مصر هذه الأيامGMT 14:47 2025 الثلاثاء ,07 كانون الثاني / يناير
المشهد في المشرق العربيصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©