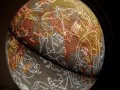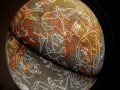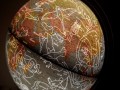الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
وطن الوقفات الخالدة
وطن الوقفات الخالدة

عوض بن حاسوم الدرمكي
بقلم -عوض بن حاسوم الدرمكي
الصوت الهادئ المحبوب، ينسلّ إلى القلوب قبل المسامع سريعاً، وبه نبرةُ حُرقةٍ وهو يتحدّث عن الثراء الذي يتنعّم به البعض، والفاقة التي تُصيب آخرين، كانت له، رحمه الله، فلسفته الإنسانية التي أتى بها كل الأنبياء والمصلحين، والتي بُنيت وأُسّست عليها دولته: «الله يعطي الإنسان عشرات ومئات الملايين، حتى يُنفق منه ويرزق غيره منه، ترى اللي خلقك هو اللي خلقهم، شو مسوّي هذا الشخص عند الله حتى يظن أنّه غير، الله عطاه الخير حتى يأخذ نصيبه ويعطي المحتاج ويساعد غيره اللي يستحي يقول إنّه محتاج»!
لم تكن فلسفة زايد عليه رحمة الله، معقدة، كما نراها، لدى كثير من القيادات، والتي تَزِن الأمور وفق حسابات كثيرة من المنفعة المتبادلة عند تقديم المساعدة، وفي كثير من الأحيان، لا تكون هذه المساعدات إلا طُعْماً للتدخل في شؤون البلاد المحتاجة، وفرض إملاءات عليها تخص قرارها السيادي وخططها الإنمائية، الاقتصادية منها والبشرية.
فهو خيرٌ صوري فقط، أما داخله فشرّ محض، لكن الأمر عند زايد وما ورّثه زايد لأبنائه، كان مختلفاً، كان هو الخير المحض الذي أتى به وحي السماء، كما قال تعالى: «وابتغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسَ نصيبك من الدنيا، وأحسِنْ كما أحسَنَ اللهُ إليك».
فمعرفةُ المآل توجّه سلوكيات الإنسان، ليكون خيّراً في داخله، والنعمة التي يتحصّل عليها ويُحسِن بها ويُعطي منها هي برهان على خيريّته الظاهرة، لا يمكن أن يكون هناك خيرٌ بالباطن ولا يظهر على السلوكيات، وهذا ما أكّد عليه زايد الخير، رحمه الله تعالى، فخيريّة الباطن يخرج نَبْتُها في أعمال الإنسان وتصرفاته «والذي خَبُثَ لا يَخْرُج إلا نَكِداً».
عندما يوافق عيد الوطن السادس والأربعين، مناسبةً أخرى، وهي «عام زايد الخير»، فما ذاك إلا للتأكيد من القيادة الرشيدة، بأنّ نهج زايد هو ما يجب أن يُرسّخ أكثر في نفوس الجميع، وبأنّه مسار الدولة، الذي لا ولن تحيد عنه، هو فعل الخير غير المشروط لكل المحتاجين، دون تقييدٍ بجنس أو عرق أو مذهب أو إقليم.
لذا، لا تسمع بحالاتٍ إنسانية طارئة في أي مكان بالعالم، إلا ودولة الإمارات هي السبّاقة بالإغاثة، والتي لم يكن غريباً إثر ذاك أن تتصدّر قائمة مانحي المساعدات الإنسانية والإغاثية على مستوى العالم لسنوات على التوالي، هو خيرٌ من أجل الخير نفسه، وليس بحثاً عن مديح في المقابل، أو منفعة لا ينظر لها إلا الصغار!
قبل أيّام، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لعطاءاته الإنسانية، والتي كان آخرها تبرعه بمليار درهم لاستئصال الأمراض الفتاكة بالأطفال في كل دول العالم، بالإضافة إلى شراكته مع مؤسسة بيل غيتس للقضاء على الفقر والأوبئة في الدول الفقيرة.
الأمر الذي يدلّل من جديد على نهج الدولة وقيادتها، والتي لا تحيد عنه منذ بدأه المؤسس العظيم، عليه رحمة الله، وهو ما يتبناه قادتها حالياً، وما تتمناه من كل أبنائها ليكونوا سنداً للإنسانية، ومشعل خير عندما يُطبِق ظلام اليأس على عيون البسطاء وأصحاب الحاجة.
من عطاءات وطن الخير، التي لا يصح أن نمر دون ذكرها، فهو عطاء لا يقوى عليه الكثيرون، إنْ لم تكن أغلبية البشر، فأبناء زايد لم يبذلوا المال فقط لمساعدة المحتاج، ولم يكتفوا بالمساعدات الغذائية والعلاجية، ولم يتوقفوا عند بناء المساكن والمستشفيات والمرافق الضرورية، على كثرة ما فعلوا وسيفعلون ذلك، ولكنهم بذلوا ما هو أغلى من ذلك بكثير، فقد وهبوا أرواحهم الطاهرة، وجادوا بدمائهم الزكيّة، من أجل نُصرة الضعيف وإغاثة المحتاج وكَسْر شوكة جماعات الدم وأرباب القتل والخراب.
وما جعلت الدولة يوم الشهيد، ليسبق يوم احتفالها السنوي بعيدها الوطني، إلا عرفاناً بأدوار هؤلاء الأبطال، عليهم رحمات الله ومغفرته، وتأكيداً على أنّ فرحة الوطن لا تكتمل، إنْ لم تُسبَق بوقفةِ فخرٍ وامتنان وعرفان لأولئك الشهداء الأبرار، الذين جادوا في سبيل نُصرة الخير بأثمن ما يملكون دون انتظار عطاءٍ من أحد، وأمثالهم كُثُر، كما قال سبحانه: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدّلوا تبديلاً».
إنّ الناجح لا يُعْدَم حاسداً أو طامعاً في نجاحاته، والدول صاحبة الإنجازات، والتي تُسطّر المآثر على كل مستويات المدنية، كما هو حال دولتنا الحبيبة، لن تكون في مأمنٍ من الطامعين، لذا، كان فِعْلُ أولئك الأبطال، هو «الخزام» الذي أُرْغِمَ به أنف من نوى شَرَّاً لهذا الوطن، ووصلت الرسالةُ جليّةً عالية الصوت للجميع، أنّ هذه الدولة المباركة، لا تملك يداً تُنْفِق وتُعطي وتُغيث المحتاج فقط.
ولكنها تملك في يدها الأخرى سِناناً باتراً، يستأصل الشرّ من أساسه، وبندقيةً قد دخلت سوق الموت، فباعت فيه من أرواح الأعداء واشترت كيف شاءت، فمن أراد الخير، فنحن أهله وأولى الناس به، ومن أراد الشر «خزمناه بخشمه» خزم البعير!
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة - مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما �...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - صوت الإمارات
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©