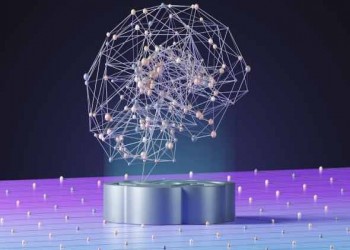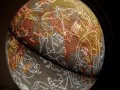الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
السدرة التي حملت رسائلي
السدرة التي حملت رسائلي

بقلم : علي ابو الريش
السدرة التي تحملتني كثيراً، وحملت رسائلي، لأجل أن تقرأها نجمة السماء، وتحفظها الغيمة مع المطر، تلك القصة التي وجفت لها قلوب، وارتجفت لأجلها أصابع، وارتعدت فرائص، ولم يعد في الإمكان إيقاف عقارب الساعة، لأنها كانت أسرع من الدورة الدموية في الجسد.
تلك السدرة قامت في الصباح الباكر ناشرة خصلاتها الخضراء، مبدية دلال عصافيرها وهي ترفع النشيد الأبدي عالياً، رافلة بنشوة الغناء الصباحي كأنها أنشودة المطر لبدر شاكر السياب، كأنها الودق الذي حل على رمل الذاكرة، فأرخى قطراته مثل حبات خال على وجنتين كاللجين، هنا عند هذه الخالدة السائدة، كانت تقف الطيور، وهي ترسم صورة الأبدية على أجنحتها، وتحدق في الوجوه، ثم تحلق، ثم تعلق على مشجب الحياة أجمل ما جاء في خلد الكون، وتطير، ومعها كانت أفئدة تطير، وتذهب لتحكي القصة كاملة لكن تحب، وتهوى، وكانت السدرة تحفظ جل ما خفقت به القلوب، وما جاء في خاطر المحبين من مكارم الشوق، والتوق، وما ساورهم من ظنون، وفنون، وفتون العشق في ذلك النسق الوجداني الذي مزق غشاء الليالي في ساعة حومة وانتهى به الأمر أن وصل إلى منتهى الجنون الجميل، إنه جنون البراءة، وعفوية الوصول إلى ذروة الوعي بقيمة الصور التي نلتقيها، والصور التي تحكم قبضتها في الصدور.
تلك السدرة هي لم تزل فوق الأرض، وفي عمق الذاكرة، وعند شغاف الحلم، ترصع الفكرة بقلائد، وتضع على النحر شامة، وعلامة على أن هذا الصبي الذي كان، كان عند جذع السدرة، لا يناور من أجل حبة نبق، وإنما كان يحاور الأشواق عندما تصبح الأشواق صوراً، ووجوه لا تمشي على الأرض، وإنما خطواتها محفورة في القلب، وبريق عيونها منحوت في الروح.
في الآونة الأخيرة، أي قبل عشرين عاماً من الآن عاينت السدرة ملياً، وتفكرت وبصرت، وتأملت فلم أجد تلك الطيور التي أحببتها، لم أجد عناقيد الثمرات التي أحببتها، ولم أجد نفسي هناك، كنت فقط في الفراغ، ألملم بقايا كائن مر من هنا في يوم من الأيام كان والهاً إلى حد الثمالة، كان مدنفاً إلى حد الغياب، ولكن كل ذلك ذهب مع ما ذهب وولى وأدبر، والأشياء تتلاشى على حين غرة، وتمضي في الغياب تبحث عن سر الوجود، ولا وجود لمن لم يجد مكانه في هذا العالم، وفي صدر امرأة تخضب الحناء من أجل ليلة فيها القمر يلبس ثوب الفرح، والنجوم رواقص، والغيمة تنسج خيوط معرفتها بالكون، عبر دفقات البلل النبيل.
في نهاية الأمر الأشياء تزول، وتبقى آثارها على الأرض مثل الجروح القديمة، مثل الحب الذي لم تكتمل حكايته.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد
GMT 09:11 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
أحلام قطرية – تركية لم تتحققGMT 09:06 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
تذكرة.. وحقيبة سفر- 1GMT 09:03 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
عندما تصادف شخصًا ماGMT 08:58 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
اختبار الحرية الصعب!GMT 00:41 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
وماذا عن الشيعة المستقلين؟ وماذا عن الشيعة المستقلين؟صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©