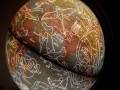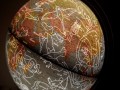الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
عيوب الآخرين تساعدنا على تقبل عيوبنا
عيوب الآخرين تساعدنا على تقبل عيوبنا

بقلم - علي ابو الريش
ربما نتقبل عيوبنا، لأننا نرى في الآخرين عيوباً، فنسقط ما فينا عليهم ونقول: ها هم كذلك لديهم عيوب، فلماذا نجزع؟ ولماذا لا نقتنع بأن الحياة دائرة عيب كبيرة، كلنا ندور فيها، ولا نهاية للعيوب.
هذه فكرة جهنمية اخترعها الإنسان، ليهرب من الحقيقة، وليتخفف من أعباء التأنيب، وينظر إلى الحياة بتفاؤل قليل، مقابل التشاؤم الكثير.
الإنسان جاء متشائماً وغير مبتسم، وبعد محاولات يائسة من قبل الوالدين، ومداعبات، وملاعبات، ومشاغبات، يبدأ الإنسان في الإفراج عن الابتسامة بعسر، ولكن خلف كل ابتسامة هناك صرخة محتبسة، قد تخرج إلى الوجود في أي لحظة، ولمجرد التفاتة بسيطة نحو الفراغ اللامتناهي، تعود الصرخة مدوية، تفجر شرنقة الابتسامة، وتحولها إلى حفل جنائزي مريع.
الإنسان يهرب من كل شيء عدا الإسقاط، لأنه المعول الذي يحفر به قبر عيوبه، ولأنه المكنسة التي يطرد من خلالها إحساسه بالنقص، ولأنه الهدير الذي يخيف به شبح دونيته.
أعظم اختراع توصل إليه الإنسان، وهو الأقدم هو الإسقاط.
المرأة القبيحة، تصف الجميلات بالتبرج والغنج، والبطر أحياناً، والجاهل يشمئز من الشخص المتعلم، ويصفه بـ«المتفلسف»، والفقير يتحدث كثيراً عن القناعة، ويسرد حولها القصص والحكايات، وهكذا تستمر عربة الإسقاط تنمو وتتورم وتكبر وتنتفخ مثل البالون، ولكن لابد وأن تنفجر في وجه صاحبها لأنها خدعة، والخداع لا يصمد أمام الحقائق، لأن الحقائق من صنع الطبيعة، والخداع من صنع الإنسان، وكل ما يقوم به الإنسان من أفعال مؤقتة، كما هو الإنسان ابن زمنه، ولا يمكن أن يكون للإسقاط أكثر من دور الفقاعة، فهي تبرز على سطح الماء نتيجة لتصادم موجتين، وما أن تنتهي حرارة الصدام، تنتهي الفقاعة إلى لا شيء.
الإنسان اخترع الإسقاط، ليحرر نفسه من السقوط في بئر الخيانة العظمى، وليخلص نفسه من الإحساس بالضعف، وكل ما يسعى إليه الإنسان هو إيجاد موطئ قدم على رصيف الوجود، والتأكيد أنه موجود، رغم ما يداهمه من موجات حرارية، كثيراً ما تؤدي إلى اختزاله وتحويله إلى ابتسامة ناقصة البياض.
فالإسقاط هو مثل الحلم، يحقق للإنسان ما لم يستطع تحقيقه في الواقع، ويزرع ابتسامة على الوجه، حتى وإن كانت مؤقتة. الإسقاط مثل مساحيق التجميل.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن جريدة الاتحاد
GMT 21:27 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
قصة عِبَارة تشبه الخنجرGMT 21:21 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
المرأة ونظرية المتبرجة تستاهلGMT 21:17 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
«تكوين»GMT 21:10 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
هل يعاقب فيفا إسرائيل أم يكون «فيفى»؟!GMT 21:06 2024 الأربعاء ,15 أيار / مايو
العالم عند مفترق طرقمخاوف الحرب التجارية تدفع الذهب للارتفاع وسط ترقب للبيانات الأميركية
واشنطن - صوت الإمارات
ارتفع الذهب يوم الخميس حيث تتبّعت الأسواق من كثب تطورات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية التي قد تزيد من حدة الحرب التجارية العالمية، بينما يترقّب المستثمرون بيانات أميركية مهمة من المقرر ص...المزيدترمب ينتقد تايلور سويفت بعد تعرضها لصيحات استهجان في السوبر بول ويصفها بأنها شخصية ليبرالية مؤيدة للديمقراطيين
واشنطن - صوت الإمارات
علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تعرض المغنية تايلور سويفت لصيحات استهجان من الجمهور وقت ظهورها في نهائي السوبر بول، إذ كتب على منصته Truth Social: "الشخص الوحيد الذي قضى ليلة أصعب من فريق كنساس سيتي، هو تايلور سويف...المزيدمنصة "إكس" توافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب بشأن حظر حسابه
واشنطن - صوت الإمارات
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء، 12 فبراير 2025، وافقت منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر) والمملوكة لإيلون ماسك، على دفع حوالي 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريك...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدصلاح يواصل تألقه ويعزز موقعه بين أفضل الهدافين التاريخيين للبريميرليغ
لندن - العرب اليوم
واصل النجم المصري محمد صلاح مسيرته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من تسجيل هدف جديد في مباراة فريقه. الهدف الذي أحرزه صلاح لم يكن مجرد إضافة إلى رصيده الشخصي فحسب، بل ساعد في تعزيز مكانته في قائمة اله...المزيددراسة تؤكد فوائد الاستحمام بالماء البارد بعد التمرين في تعزيز التعافي وتحسين النوم
واشنطن - صوت الإمارات
أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاستحمام بالماء البارد أو غمر الجسم في الثلج بعد التمارين الرياضية العنيفة له فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تحسين جودة النوم. قام فريق من جامعة جنوب أستراليا بمراجعة 12 دراسة بحثية حول فو�...المزيدأحلام تتألق بإطلالة لامعة فخمة في عيد ميلادها
القاهرة - صوت الإمارات
احتفلت الملكة أحلام قبيل ليلة عيد الحب بعيد ميلادها في أجواء من الفخامة التي تعكس عشقها للمجوهرات الفاخرة، باحتفال رومانسي مع زوجها مبارك الهاجري، ولفتت الأنظار كعادتها باطلالاتها اللامعة، التي اتسمت بنفس الطابع الفاخر الذي عودتها عليه، بنكهة تراثية ومحتشمة، دون أن تترك بصمتها المعاصرة، لتتوهج كعادتها بتنسيق استثنائي لم يفشل في حصد الإعجاب، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك دعونا نفتش معا في خزانة المطربة العاشقة للأناقة الملكية أحلام، لنستلهم من إطلالاتها الوقورة ما يناسب الأجواء الرمضانية، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ57. أحلام تتألق بإطلالة لامعة في عيد ميلادها تباهت الملكة أحلام في سهرة عيد ميلادها التي تسبق عيد الحب باحتفال رومانسي يوحي بالفخامة برفقة زوجها مبارك الهاجري، وظهرت أحلام بأناقتها المعتادة في ذلك ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©