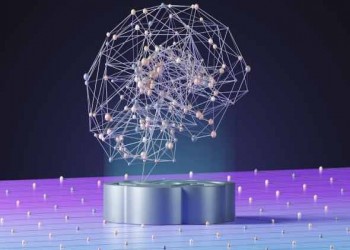الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
عندما نتخلص من العادة نصبح أسوياء
عندما نتخلص من العادة نصبح أسوياء

بقلم : علي أبو الريش
العادة ضمير فاسد، لا يصحو إلا عندما يكون بين الرثاثة، نلاحظ ذلك في سعي الإنسان الرتيب إلى تكريس حزمة من الأفعال خارج الوعي، وينضم إلى مجموعة من الموجات المتراكمة عند شطآن لا حدود لقواقعها الميتة، ونحن اليوم في عصر العمى الشعوري، نجد الإنسان الثانوي هو تلك العجلة المستديرة حول نفسها من دون هدف، بل هو مثل المروحة التي يطوح بها الهوى على غير هدى، ومن دون غاية محددة، الأمر الذي يحول هذه المروحة إلى مزق، بفعل الدوران العشوائي.
العادة كثيراً ما تأخذ صاحبها إلى الهوى، والهوى هو غاية الشخص اللاواعي، المأخوذ بفعل الإرادة المستلبة، عادة الاستهلاك مثلاً، تغرق الفرد في سلبيات لا نهاية لها، وقد تغوص به في مأزق الاستدانة، والاستدارة حول نفسه في مصارف العبث اللانهائية، ما يجعل الفرد يحط في دهاليز المحاكمات والسجون، والتي لا تنتهي أسوارها مهما اتسعت لدى الفرد من مشاعر الإدانة والتقريع والنبذ والتوبيخ، لأن العادة أقوى من تأنيب الضمير، بل وأقوى من عذابات الأسوار العالية، لأن في العادة قبر للضمير، وفي العادة موت محقق لروح أصبحت مثل أحفورة قرون بدائية.
اليوم أضحت العادة مراناً يومياً، تمارسه نفس المعتاد على الشخص، ولا يجد ما يبرر تكرارها، وكذلك إيجاد الحل لها، لأنه عندما تستعبد العادة المرء، فهو يمضي إلى تكرار أخطائه، بيقين أعمى، وبصيرة خبأت وعيها في صندوق أسود، مغلق بأقفال فولاذية، لا يفكها الشديد القوي.
أسر تضيع، ومصائر تهدر وعلاقات اجتماعية تتفكك، وتضاعف مستوى حالات الطلاق، بسبب العادة التي تأخذ بعض الأشخاص بعيداً عن منطق التعامل مع شأن الحياة، بعدالة ضمير واع، وإرادة صلبة، وعزيمة متماسكة، لأن العادة إن وجدت لها قناة مرور عبر النفس، فإنها تصبح مثل الورم الخبيث، لا علاج له إلا بالبتر، أو يصبح متفشياً متوغلاً متغلغلاً، متوحشاً، متمكناً من روح الإنسان ولبه.
ليس هناك شرف في العادة، ولا ميثاق، ولا عدل، ولا ميزان، ولا أخلاق، ولا قيم، بل هناك الحالة الفنائية للذات، وعدمية الرؤى، وعبثية السلوك، فالعادة تحول الشخص البالغ إلى طفل، وأحياناً إلى بهيمة الأَنْعَام، يقوم الشخص بتصرفاته، من دون وازع ولا رادع ولا مانع، لأنه لا يملك قدرة الكبح لما يفعله، إنه شخص مستَلب، مغلوب على أمره، واقع في منزلق الإرادة المغلولة.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©