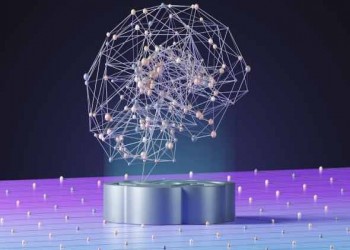الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
خيانة الماضي
خيانة الماضي

بقلم : علي أبو الريش
عندما يفكر الإنسان في التحول من الماضي إلى المستقبل، متجاوزاً الحاضر، وبسرعة البرق، فإنه يفعل ذلك كمن يمشي على الحبل، لينتقل من مبنى شاهق إلى مبنى آخر.
ويكون بذلك على حافة الخطر. ما بين المبنيين، هوة عميقة، السقوط فيها يعني الهلاك المحقق، والموت المحتوم. الآن وفي لحظة القفز، من مرحلة إلى أخرى، يتم فيها حرق المراحل، التي يتلوها، تهشيم الذات، المبنية أساساً على تراكم خبرات ومعارف وعادات، وفي القفزة المباغتة تتبعثر تلك الكتل القابضة على الروح، ويصبح الإنسان، بلا كيان أو أنه يصير، مثل خيمة صغيرة، عصفت بها الريح، وتناثرت أعمدتها، وأصبحت أشلاء.
الماضي قد يبدو أثاثاً قديماً في عين الجيل الجديد، وقد لا يعنيه أي شيء لم يعشه، ولكن في واقع الأمر لا يمكن للفرد مهما صغر سنه، ولم يعش ماضي غيره من الآباء، لكن هذا الماضي، ليس قطعة قماش، بالية من السهل الاستغناء عنها، بل هو جزء لا يتجزأ من حياة هو كامن في النفس، ويشكل البعد الروحي للأفراد، حتى الذين لم يعيشوه، لأنه ما من شخص جاء من الفراغ، ولا أحد بدأ من الصفر، بل إن حياة الناس، هي مثل سلسلة مكونة من حبات متتالية، والاستغناء عن إحداها، يعني انفلات الحبات الأخرى، وضياع السلسلة. الماضي قاعدة البناء الشخصي،
وتجاوزه يعني هدم الجدران، وبقاء البيت مفتوحاً، وبلا جدران، الأمر الذي يعرضه لخطر الاختراق والانتهاك وغزو العيون المتربصة، وانكشاف ما بداخله، بمعنى أنه يصبح عارياً وسهلاً لدخول الغبار، والحشرات الضارة. ما يحدث في العالم هو هذا التفكيك، لمسامير الألواح التي تكون القارب، الأمر الذي يحوله إلى أشلاء، أو فعل ماضٍ، لا يمكن الرجوع إليه. هذا التفكيك هو ما جعل الحياة شبه سائلة، أي مثل المجرى المائي، الذي لا ضفاف له، وبالتالي، يضيع الماء، ويهدر، ويذهب بعيداً عن الحقل، فلا تستفيد منه الأشجار. النظرة إلى المستقبل، تصبح من العبث، إذا لم يحدد الإنسان الهدف، وإذا لم يضع قدميه على أرض الماضي الصلبة، لينطلق بثبات وثقة، وصرامة، وحزم، وجزم، ومعرفة لما يريد، ووعي بمقدمات المستقبل، وجوهر الحاضر.
الجيل الحديث، وقع في فخ الإبهار، والصدمة الحضارية التي أفقدته القدرة على الإمساك باللحظة، ما جعل الزمن يتسرب من بين مقلتيه، مثل فنجان القهوة المسكوب من يد متوترة، فقد بدا الزمن يسير على طرقات وعرة، وأزقة مزدحمة، فلا يوجد ما يفصلها ليحدد الماشي مكانه المراد الوصول إليه، وهنا تضيع البوصلة، وتختفي المعالم، ويتلاشى الهدف، ويصبح الفرد، يمشي فقط، ولا يدري إلى أين، وبعد حين، يجد نفسه وسط الفراغ الذي يقذف به في اللامنتمي، ومن هذه النقطة يخرج الحلم من باب خيمته ليدخل الوهم. ونحن في الوهم، نصبح بلا ملامح، بل وجوهنا، تبدو مثل مرايا مكسورة، وأرواحنا مخطوفة، وقلوبنا مسكونة بالألق، لأنه لا شيء يجذبنا، ولا شيء نحبه حتى نسعى إليه، بل كل ما نفعله هو الوقوف عند المحطات، ليس للتأمل، بل للتأهب للانتقال إلى محطات أخرى، فنحن في حالة الصدمة، مثل الأشخاص المفلسين، نجدهم يقفون أمام فاترينات المحلات الراقية ليس لانتقاء ما يودون شراءه، بل لإقناع أنفسهم، أنهم رأوا، بديلاً ما، يستطيعون مجاراة الآخرين في معرفته، كما أن المشاهدة المتكررة تغني المفلس عن الامتلاك.
GMT 09:11 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
أحلام قطرية – تركية لم تتحققGMT 09:06 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
تذكرة.. وحقيبة سفر- 1GMT 09:03 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
عندما تصادف شخصًا ماGMT 08:58 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
اختبار الحرية الصعب!GMT 00:41 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
وماذا عن الشيعة المستقلين؟ وماذا عن الشيعة المستقلين؟صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©