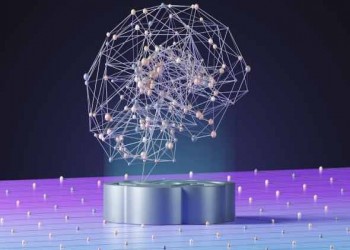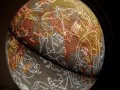الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
درجة الحرارة اللاهبة لم تثنهم عن الإبداع
درجة الحرارة اللاهبة لم تثنهم عن الإبداع

بقلم : علي ابو الريش
تدخل البيت ومكيفات الهواء تضخ صقيعها والزوجة تصيح (حرانة)، ويأتي الأبناء من الخارج، وبمعية سيارات مكيفة، وهم يلهثون وأصابعهم مثل مساحات الزجاج تطوف على الجبهات المغضنة، والخادمة في البيت تمد شفتيها مكتئبة من سوء ما تواجهه من متاعب تحت اللظى، فتتذكر أنت الذي عاصرت العريش وهفهفات الخرق المنشورة فوق الأسقف السعفية، مثل أشرعة مراكب قديمة، تتذكر أولئك الصناديد وماجدات الزمن الجميل، وهن يحلبن المواشي، ويخضضن اللبن، ويجلبن صفائح الماء من مناطق تبعد بعشرات الكيلومترات، وهن يعزفن لحن الخلود من دون أناة أو آهات، وكن هن المشرعات لخوض المسافات الطويلة من حياة لم تكن مفروشة بالورود، لكنها كانت مؤثثة بوجدان إنساني لا يعرف التأفف، ولا يخنع لقسوة الظرف، كانت الحياة لذلك الجيل موشومة بالحب والإرادة التي لا تلين ولا تستكين، كانت حياة النبلاء من نسل صحراء أنجبت عباقرة صناعة الحلم، وجهابذة تشكيل الفرح من لون النخلة الوارفة، ومن نسيج الرمل الأصفر، وعلى سيمفونية الموجة الراقصة عند سواحل الأمل والانتظار الطويل لعودة المسافر، ومجيء السواعد السمر بعد غياب من أجل بلاغة الأمنيات التي لا تحدها خدود، ولا تمنعها حرقة صيف، ولا حماقة موجة، ولا شراسة فك مفترس.
هؤلاء عندما نتذكرهم ونستعيد أمجادهم، ونستدعي العقل كي يضع مقاييسه الموزونة بالضمير الحي، نشعر بضآلة مكانتنا، وضحالة جيل استسهل الحصول على الأشياء وصار عالة على الوجود، وكلما كبر الشاب، ونضجت المرأة ازدادوا اتكالية وتقاعساً عن جلب ما يمنع عنهم الكلل، ومد اليد لولي أمر، أو كبير العائلة.
عندما نستحضر أولئك الأبطال نصغر نحن، ونبدو مثل بقايا ما تبقى من تاريخ لا نستطيع استعادته، ولو لمجرد احتفاء بما غاب وتلاشى، نشعر بتأنيب الضمير ونحن نتذكر ما أنجزه أولئك، لأننا ونحن ننظر إلى وجوه الحاضرين ينتابنا اليأس، فهؤلاء بدوا عاجزين عن صناعة ما يرفع عنهم العتب، فهؤلاء لا يريدون أن يفعلوا شيئاً، هؤلاء اتكأوا على أريكة الهواء البارد، ويخشون من العرق، ورائحته تجعلهم (بلا قيمة) أمام الزوجة أو الزوج، هؤلاء غادروا منطقة أحلام السفر الطويل، واكتفوا البقاء في المكان الذي لا يسبب العرق، هؤلاء جيل يحتاج إلى مناهج جديدة، تعلمه ماذا كان يفعل الأولون الذين واجهوا لظى الصيف وشظف الحياة.
المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
نقلا عن الاتحاد
GMT 09:11 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
أحلام قطرية – تركية لم تتحققGMT 09:06 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
تذكرة.. وحقيبة سفر- 1GMT 09:03 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
عندما تصادف شخصًا ماGMT 08:58 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
اختبار الحرية الصعب!GMT 00:41 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر
وماذا عن الشيعة المستقلين؟ وماذا عن الشيعة المستقلين؟صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©