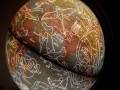الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
عزيزتى «هند صبرى»... أنا «شولة» أيضًا!
عزيزتى «هند صبرى»... أنا «شولة» أيضًا!

فاطمة ناعوت
بقلم : فاطمة ناعوت
وُلدتُ «عسراءَ»، أى أستخدمُ يدى اليسرى فى الكتابة والأكل والقبض على المضرب فى لعب التنس والبنج بونج، وفى كافة أمور حياتى. ولا أذكرُ مطلقًا أننى تعرضتُ للتنمّر فى طفولتى بسبب كونى «شولة» لا فى مدرستى CGC، ولا فى محيط الأسرة والأصدقاء، ولا فى مسجد الحى الذى كنتُ أذهب إليه مع شقيقى لتعلّم القرآن الكريم. فى البَدء، اندهشت أمى حين لاحظت استعمالى يدى اليسرى، واستشارت طبيب الأطفال أ. د. «محمود العيسوى»، فشرح لها ببساطة أن هذا غير مقلق بالمرّة، بل هو عنصر تميّز لأن فصّ المخ الأيمن المسؤول عن الإبداع والمواهب هو الأنشط لدى مستخدمى اليد اليسرى؛ وهذا سبب أن كثيرًا من عباقرة الرسم والموسيقى والرياضة والعلوم يستخدمون اليد اليسرى. وشدّد الطبيبُ على أمى ألا تحاول إجبارى على استعمال اليد اليمنى كما تفعل بعضُ الأمهات؛ أولًا لأنه مستحيل؛ بسبب الترتيب الوظيفى للدماغ لدىَّ، وثانيًا لأن هذا يُعتبر: «Child Abuse» أو «إساءة معاملة الأطفال».
أكتبُ هذا بسبب تصريح الفنانة الجميلة «هند صبرى»، حيث قالت: (بنتى علياء شولة، ومدرّسة منزلية كانت بتغصبها تكتب بإيدها اليمين بزعم إن ده حرام وهاتدخل النار!. للأسف أغلب الناس بتتربى على الخوف أكتر من السعى لمعرفة ربنا!). انتهى تصريح الفنانة، وأرفعُ ألفَ «علامة تعجب» فى وجه مُعلمة غير مؤهلة، تعبثُ بنفسية طفلة تتهيأ للحياة!!!!!.
أتركُ الطفلةَ الجميلة «علياء»، وأعودُ بالزمن إلى الطفلة التى كنتُها منذ بضعة عقود خَلَت. أتذكّرُ مدرستى الجميلة CGC، التى نحتفل الشهر القادم بعيدها المئوى؛ إذ وُضِع حجرُ الأساس يوم ٤ مايو ١٩١٤. أُقلِّبُ صفحات دفتر طفولتى، فلا أقبضُ على لحظة «تنمّر» واحدة كونى «شولة» من معلماتى. بل كنتُ أحلمُ أن أغدو «معلّمة» لأشبه معلماتى الجميلات اللواتى كُنّ فى خيالى مثل «ربّات الحكمة والجمال» فى الميثولوجيا الإغريقية، وذلك بسبب الواقعة التالية.
كنتُ فى سنة أولى حين طلبت إلينا «ميس راشيل» كتابة الكلمات الإنجليزية التى تعلمناها فى الحصة السابقة. وكانت تمرُّ بين الطاولات، ثم توقّفت فجأة إلى جوار ديسكى، ولم تتحرك!. رفعتُ نظرى نحوها فوجدتها تنظر إلى كراستى باهتمام. راح قلبى يخفقُ وقد تيقنتُ أننى أخطأتُ فى الحروف!، وكلما رفعتُ عينى إليها فى تساؤل صامت، أومأت لى بعينيها لأكمل الكتابة.مرت الدقائقُ ثقالًا كأنها الدهر. وفجأة طُرق بابُ الفصل، ودخلت «ميس عايدة»، معلّمة العربى، لتستعير من فصلنا قطعةَ طباشير. قالت «ميس راشيل»: (تعالى شوفى يا عايدة!) أشارت إلى كراستى وأردفت: (البنت دى شولة، ومع كده خطها جنان، ما شاء الله!)، فردّت عليها «ميس عايدة»: (وخطها حلو فى العربى كمان!).
دعك من الإطراء والخط الحلو!، فما حدث هو أننى صُعِقت من هذا الحوار القصير بين المعلمتين! كيف عرفت «ميس راشيل» أننى «شولة»!!!!!، هذا سرٌّ عائلى غير مُعلن!.
فى عمرى الصغير وقتها، كنتُ أعتقدُ أن «شولة» هذه «مرضٌ» لا يعرفه إلا أسرتى والأصدقاء الذين تبثُّ لهم أمى همومها. فقد كانت تقول لصديقاتها فى نبرة قلق: («فافى» شولة للأسف، وحاولت معها كتير تكتب وتاكل باليمين!، بس الدكتور قالى: مفيش فايدة!)، و«فافى» هى أنا بالطبع. ولكن، كيف عرفت «ميس راشيل» هذا السر العائلى الخطير؟!. يومها ركضتُ لأمى مبهورةَ الأنفاس وهتفتُ فيها بأعلى صوتى:
(ماما… «ميس راشيل» بتعرف كل حاجة فى الدنيا!، وعرفت كمان السر!. أنا عاوزة أبقى مدرّسة زيها عشان أعرف كل حاجة من غير ما حد يقولى!). وسألتنى أمى: (ميس راشيل عرفت سرّ إيه؟)، قلتُ: (عرفت إنى شولة!، والمصحف يا ماما أنا مقولتلهاش!. هى عرفت لوحدها!!!!). وانفجرت أمى فى الضحك، وصارت هذه الواقعةُ الطريفة حديثَ العائلة لسنوات طويلة. ولكنها أكدت رغبتى العارمة فى أن أغدو معلّمة ذات يوم لكى أحوز معارفَ الدنيا. وأما ماذا صنع بى حُلمى القديم بأن أكون معلّمة حين أكبر، فقد تحولتُ إلى «لصّة» من أجل الوصول إلى ذلك الحلم الصعب. وهذا ما سأقصُّه عليكم فى مقال قادم.
من نُثار خواطرى:
(طفلةٌ عسراءُ)
أمسكت كراسةَ الإملاء
وقالتْ للمعلمةِ الأخرى:
«طفلةٌ عسراء،
خطُّها رائع!»
...........
سيكبُر الأطفالُ
وتكبرُ أقدامُهم
وبدلًا من الركضِ فى دوائرَ
سيتعلمون السيرَ بخطواتٍ واسعةٍ
نحو الحياة
أما الطفلةُ التى كنتُها
ولأن قدمَها محشورةٌ
فى حذاءٍ حديدىّ
ستظلُّ
تركضُ فى دوائرَ
حتى تنتبه الحياةُ
وتقول:
العسراءُ تلك
كانت فى شرنقتى
ثم طارت
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتمخاوف الحرب التجارية تدفع الذهب للارتفاع وسط ترقب للبيانات الأميركية
واشنطن - صوت الإمارات
ارتفع الذهب يوم الخميس حيث تتبّعت الأسواق من كثب تطورات خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن التعريفات الجمركية التي قد تزيد من حدة الحرب التجارية العالمية، بينما يترقّب المستثمرون بيانات أميركية مهمة من المقرر ص...المزيدترمب ينتقد تايلور سويفت بعد تعرضها لصيحات استهجان في السوبر بول ويصفها بأنها شخصية ليبرالية مؤيدة للديمقراطيين
واشنطن - صوت الإمارات
علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تعرض المغنية تايلور سويفت لصيحات استهجان من الجمهور وقت ظهورها في نهائي السوبر بول، إذ كتب على منصته Truth Social: "الشخص الوحيد الذي قضى ليلة أصعب من فريق كنساس سيتي، هو تايلور سويف...المزيدمنصة "إكس" توافق على دفع 10 ملايين دولار لتسوية دعوى ترامب بشأن حظر حسابه
واشنطن - صوت الإمارات
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الأربعاء، 12 فبراير 2025، وافقت منصة "إكس" (المعروفة سابقًا بتويتر) والمملوكة لإيلون ماسك، على دفع حوالي 10 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريك...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدصلاح يواصل تألقه ويعزز موقعه بين أفضل الهدافين التاريخيين للبريميرليغ
لندن - العرب اليوم
واصل النجم المصري محمد صلاح مسيرته الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تمكن من تسجيل هدف جديد في مباراة فريقه. الهدف الذي أحرزه صلاح لم يكن مجرد إضافة إلى رصيده الشخصي فحسب، بل ساعد في تعزيز مكانته في قائمة اله...المزيددراسة تؤكد فوائد الاستحمام بالماء البارد بعد التمرين في تعزيز التعافي وتحسين النوم
واشنطن - صوت الإمارات
أظهرت دراسة علمية حديثة أن الاستحمام بالماء البارد أو غمر الجسم في الثلج بعد التمارين الرياضية العنيفة له فوائد صحية متعددة، بما في ذلك تحسين جودة النوم. قام فريق من جامعة جنوب أستراليا بمراجعة 12 دراسة بحثية حول فو�...المزيدأحلام تتألق بإطلالة لامعة فخمة في عيد ميلادها
القاهرة - صوت الإمارات
احتفلت الملكة أحلام قبيل ليلة عيد الحب بعيد ميلادها في أجواء من الفخامة التي تعكس عشقها للمجوهرات الفاخرة، باحتفال رومانسي مع زوجها مبارك الهاجري، ولفتت الأنظار كعادتها باطلالاتها اللامعة، التي اتسمت بنفس الطابع الفاخر الذي عودتها عليه، بنكهة تراثية ومحتشمة، دون أن تترك بصمتها المعاصرة، لتتوهج كعادتها بتنسيق استثنائي لم يفشل في حصد الإعجاب، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك دعونا نفتش معا في خزانة المطربة العاشقة للأناقة الملكية أحلام، لنستلهم من إطلالاتها الوقورة ما يناسب الأجواء الرمضانية، تزامنا مع احتفالها بعيد ميلادها الـ57. أحلام تتألق بإطلالة لامعة في عيد ميلادها تباهت الملكة أحلام في سهرة عيد ميلادها التي تسبق عيد الحب باحتفال رومانسي يوحي بالفخامة برفقة زوجها مبارك الهاجري، وظهرت أحلام بأناقتها المعتادة في ذلك ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©