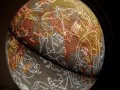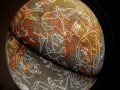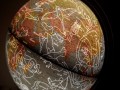الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
شاطئ جديد للسفينة الفلسطينية الحائرة
شاطئ جديد للسفينة الفلسطينية الحائرة

بقلم -فؤاد مطر
تحت تأثير حالة إحباط استقرت في النفس العربية عموماً وفي النفس الفلسطينية بوجه خاص، ناشئة عن أن فلسطين تتراجع كقضية وباتت مجرد موضوع من الموضوعات العالقة المرجأ حسم أمرها، جاءت المحاولة الجزائرية التي استهدفت تحقيق مصالحة فلسطينية تنشر القليل من التفاؤل في مواجهة ما يعيشه الزمان العربي الحافل بالصدمات والكوابيس والرهانات غير المتناسبة مع التوقعات حتى بين الذين تجمعهم صداقات تاريخية. ولنا في افتعال بعض الأوساط الاستفزازية في «اللوبي الديمقراطي الأميركي» المثال على ذلك. ولو جاز تشخيص الدوافع من جانب أعضاء فيه لرأينا أن في الجو بداية غيوم بايدنية تتحسس من الانطلاقة النوعية في اتجاه اكتمال عملية تطوير وعلى قواعد علمية تشهدها المملكة العربية السعودية ودول الخليج عموماً، ويتم ذلك على عكس ما تراه السياسة الأميركية، بمعنى أن الشأن الأميركي يجد قبولاً له في حال أن الدولة غير متقدمة لا تجاري العصر ومنطلقة في عملية تطوير نوعية، ثم تكتشف تلك السياسة، وتحديداً بعض المنظرين فيها أن الذي يطور يملك إرادة صلبة، إضافة إلى فضاء رحب من العلاقات الاستراتيجية مع دول كبرى كثيرة تقدر مسار سياسته ورؤاه في مسألة التعامل، وأنه كلما ازداد تطويراً تراجعت الحاجة التقليدية إلى مَن يذود عنه في ساعة الحاجة إلى الذود؛ ولذا فمن مصلحة الذين اعتادوا على مكاسب علاقة استثنائية أن تنتابهم الخشية حتى إذا كانت حقاً طبيعياً ومن الثوابت يمارسه الصديق الحليف وفق رؤاه متكلاً فيما يمارس على ثقة بالنفس وثقة مضافة به من بني قومه.
كابدت الرئاسة الجزائرية الكثير من أجل الإنجاز الفلسطيني الذي لا يخرج عن كونه محاولة تأتي بعد محاولة أكثر أهمية. في البداية حدثت لقاءات لقيادات فلسطينية في الجزائر تزامنت مع اتساع مساحة التطبيع من جانب بعض الدول العربية مع إسرائيل. ارتأت الجزائر التي هي على موعد مع القمة العربية الدورية أن تؤدي دوراً تراه واجباً يمارسه الرئيس عبد المجيد تبون ويكون من نوعية أدوار سبق أن أداها الرئيس (الراحل) هواري بومدين أو الذي كان في زمنه شريكاً في صياغة هذا الدور، بدءاً بما حققته دبلوماسية هذا الشريك عبد العزيز بوتفليقة في القمة العربية الاستثنائية في الخرطوم (سبتمبر (أيلول) 1967) وبما حققه هو شخصياً خلال حرب مصر السادات عام 1973 ومثل ذلك في حرب عبد الناصر عام 1967.
الذي ارتآه الرئيس عبد المجيد تبون هو السعي لاستعادة سوريا حضورها في القمة ومنه تستعيد سيادتها بأمل استعادة مكانها ودورها وعندما لم يثمر سعيه هذا ارتأى أن تجرب الجزائر ما سبق إن كانت المملكة العربية السعودية أيام قيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز (رحمة الله عليه) قامت به وتمثل بدور سيبقى على فرادة غير مطروقة في دنيا محاولات لتحقيق المصالحات. ففي ذروة الخلاف السياسي بين «فتح» و«حماس» وبعد التشاور مع المملكة العربية السعودية التقت القيادتان الفلسطينيتان في مكة المكرمة من 6 إلى 8 فبراير (شباط) 2007، وأثمر الحرص على القضية اتفاقاً باركت المملكة مضامينه وبثت الفضائيات مشهد لقاء تاريخي بدا فيه الملك عبد الله بن عبد العزيز محاطاً بالقادة الفلسطينيين («فتح» و«حماس») مجدداً أمامهم إلى جانب التمنيات بالثبات على ما تم الاتفاق حوله القول: «لا تضيعونا وتضيعوا أنفسكم يا إخواننا أبناء القضية الفلسطينية...».
غادر الركب الفلسطيني وقد وصل الابتهاج في الديار المحتلة والمخيمات في دول عربية وحيث هنالك فلسطينيون في بلاد الاغتراب إلى حد ذرف الدموع فرحاً وبالذات عند سماعهم أو قراءاتهم كلام خالد مشعل قائلاً باسم «حماس» التي باتت رقماً صعباً في المعادلة وبالذات للعلاقة الوطيدة له وللحركة مع الرئيس بشار الأسد «إلى الذين يتخوفون ويقلقون من أن تعود الأمور إلى الوراء أقول إننا عاهدْنا الله وعاهدْنا الأمة من هذه الأرض المقدسة أن الالتزام بهذا الاتفاق سيكون كاملاً...».
مع كثير الأسف لم يصمد التفاهم. وسنة بعد سنة وصل إلى مشارف العداوة وتعززت سياسة الالتحاق أحياناً بالإيراني وأحياناً بالتركي على حساب العربي، مع أن الجانبيْن قرآ الفاتحة في لقاء مكة. دخلت إيران على الخط باجتهادات وإغراءات انتهت إلى أن حركة «حماس» غدت ضيفاً على المجموعة الممانعة، ومن دون أن يتوقف النصح السعودي الذي تمثل لاحقاً ببرقية بعد سنتيْن من الملك عبد الله إلى «فتح» لكي تسمع مضمونها «حماس» وسائر الفصائل الفلسطينية هي الأولى من نوعها، حيث جاءت في حدود خمسمائة كلمة متضمنة في ثناياها الكثير من النصح والتحذير مثل قوله: «لو أجمع العالم كله على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ولو حشد لها كل وسائل الدعم والمساندة لما قامت هذه الدولة والبيت الفلسطيني منقسم على نفسه شِيعاً وطوائف كل حزب بما لديها فرحون. إن العدو المتكبر المجرم لم يستطع عبْر سنوات طويلة من العدوان المستمر أن يُلحق من الأذى بالقضية الفلسطينية ما ألحقه الفلسطينيون أنفسهم بقضيتهم من أذى في شهور قليلة...».
خلاصة القول هي أن السعي الجزائري الذي جاء أيضاً على خلفية سعي مصري تولاه الرئيس عبد الفتاح السيسي وتواصل لقاءات وزيارات على المستويين الدبلوماسي والمخابراتي، يحقق المبتغى في حال قرر رموز الموضوع الفلسطيني أن يكونوا فلسطينيين أولاً وثانياً وآخراً وأن يجربوا صيغة الصف الواحد. وبذلك ترسو السفينة الفلسطينية الحائرة كونها تصارع الأمواج بأكثر من قبطان على شاطئ الأمان. وفي حال كُتب للمبادرة الجزائرية «مؤتمر لم الشمل من أجْل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية»، فإن هذا الإنجاز خير وبركة وتعويض على خمس عشرة سنة من الضياع والتضييع.
نقول ذلك على أساس أن الالتزام باتفاق مكة عام 2007 من خلال أجوائه الروحانية خصوصاً أن الطرفيْن أقسما اليمين على التنفيذ، كان من شأنه أن يكون الصف الفلسطيني غير مشتت على ما هي حاله طوال أربع عشرة سنة تلت ذلك الاتفاق، وكانت تصريحات الرئيس بايدن ورئيس وزراء إسرائيل يائير لبيد من نوع: «يستحق الشعب الفلسطيني أن تكون له دولة» لا تعود مثل فقاعات تتطاير في الهواء، كما لا تعود وقفة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من فوق منبر الأمم المتحدة قبل أيام وقفة مَن يستعطي وإنما مَن يتحدث من موقع قوة، ثم يباغته لاحقاً الرئيس بايدن بعتب الغاضب على لقائه بالرئيس بوتين وكأنما للرئيس الغاضب في ذمة الرئاسة الفلسطينية موقف متقدم لمصلحة القضية التي لو أرادت أميركا حلاً عادلاً لها لما كان هذا التعسير المتواصل لها.
لعل المبادرة الجزائرية تشق طريقها نحو الثبات وتلقى من القمة العربية الدورية «قمة فلسطين» بتسمية الجزائر لها، بعد أيام ما من شأنه تحقيق المزيد من التدعيم لصيغة المبادرة العربية التي لا يعود هنالك مبرر للإدارة الأميركية على التعامل معها من خلال مواقف باهتة يتم التعبير عنها بمفردات يبدو مفعولها أشبه بعلاج غير فعال بقرارات حاسمة وليس بعبارات غير ذات جدوى لخمسة وسبعين عاماً من الظلم وبات لا بد من التكفير عن الذنوب. والله الحق والتواب.
GMT 02:30 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السادة الرؤساء وسيدات الهامشGMT 02:28 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (10)GMT 02:27 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
من يفوز بالطالب: سوق العمل أم التخصص الأكاديمي؟GMT 02:26 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
روبرت مالي: التغريدة التي تقول كل شيءGMT 02:24 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السعودية وفشل الضغوط الأميركيةصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمنى زكي تؤكد أنها تتأنى دائما في اختياراتها لأعمالها وفيلم "الست" تحدٍ صعب لها
القاهرة - مصر اليوم
تحدثت الفنانة منى زكي عن سعادتها بتكريمها الأخير بجائزة اليسر الذهبي الفخرية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. وكشفت عن سر اختيارها لأعمالها الفنية وما تعلمته من كبار المخرجين والنجوم الذين عملت معهم، كما �...المزيدتحقيق يكشف عن تقييد "فيسبوك" للصفحات الإخبارية الفلسطينية
غزة - صوت الإمارات
قيّد موقع فيسبوك بشدة قدرة وسائل الإعلام الفلسطينية على الوصول إلى الجمهور خلال الحرب بين إسرائيل وغزة. وفي تحليل شامل لبيانات فيسبوك، وجدنا أن غرف الأخبار في الأراضي الفلسطينية - في غزة والضفة الغربية - شهدت انخفا�...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©