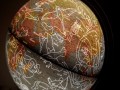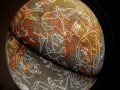الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
الحرب الأوكرانية والثنائية القطبية الدولية
الحرب الأوكرانية والثنائية القطبية الدولية

بقلم - إميل أمين
هل جاءت الحرب الأوكرانية لتعيد العالم إلى مساراته ثنائية القطبية، ومدارات زمن الحرب الباردة مرة جديدة، هذا على الرغم من غياب الاتحاد السوفيتي، ومضيه إلى غياهب النسيان قبل ثلاثة عقود؟
التساؤل يستدعي عودة إلى الماضي القريب، وتحديدا عند حدود العام 2008، أي زمن الأزمة المالية العالمية، تلك التي تسببت فيها البنوك الأميركية، ويومها كتب المنظر الأميركي الأشهر، ريتشار هاس، عن رؤيته لعالم متعدد الأقطاب، وقد كان ذلك بعد نحو عقدين من سقوط الاتحاد السوفيتي، واعتقاد الجميع أن واشنطن انفردت بالقطبية الأممية، وتسنمت قمة العالم.
هاس، رأى أن فكرة أميركا مالئة الدنيا وشاغلة الناس وحدها، ومن غير ند يزاحمها، أو شريك يضايقها، قد ولى زمانها، فيما رأى غيره من المنظرين مثل البروفيسور الأميركي الإيراني الأصل، ولي نصر، أن مفهوم أميركا التي لا يمكن الاستغناء عنها، بدوره لم يعد صالحا، وأن هناك بدائل عدة تجعل من الاستغناء عن واشنطن أمرا محبوبا، وربما مرغوب.
كان القاسم الأعظم المشترك بين هاس ونصر، هو فكرة نشوء وارتقاء أقطاب متعددة، وربما كانت البصمة الآسيوية واضحة جدا في ذلك التوقيت، وبتأثير من الصعود والازدهار الصيني، الذي لا يحد ولا يمد، عطفا على أن الاتحاد الأوربي في ذلك التوقيت، كان يعيش فترة الحصاد الوفير لتعاون الشعوب الأوروبية.
غير أننا لا نغالي إن قلنا إن ما جرى منذ فبراير شباط الماضي، وحتى اليوم، يدعونا لمراجعة رؤى المفكرين الأميركيين الكبيرين، إذ تبدو واشنطن وموسكو، ومرة أخرى، ولعلها مصادفات القدر، حجري الرحى في النظام الأممي المعاصر.
رفضت موسكو أن يقترب الناتو من حدودها بشكل أو بآخر، ولم يكن أمامها سوى طريق من اثنين، لا ثالث لهما في عالم الدبلوماسية، الاحتواء أو الردع.
لبضعة سنوات مالت موسكو للتهديد والوعيد، عله يكون الطريق إلى الاحتواء، لكن ذلك لم يفت في عضد الذين يقفون خلف أوكرانيا، ويدعمون مشروع الناتو التوسعي شرقا، وفي الخلفية واشنطن بوضوح تام.
من هنا بدا وكأن القطبية السوفيتية باتت إرثا روسيا في الحال والاستقبال، ولهذا عمد القيصر تجاه تفعيل قوته العسكرية، ما ظهر منها حتى الساعة، فيما يخشى المراقبون أن يكون الأسوأ والسري غاطسا كمثل جبل الثلج في الأعماق، ويكاد ظهوره يكون كارثيا لو قدر له الظهور.
في مقابل موسكو، ومن غير مواراة أو مداراة، تظهر واشنطن المكافئ الموضوعي المنتبه جيدا للردع، لاسيما أنها هي من يملك من أدوات الدبلوماسية تارة، والقوة تارة أخرى، ما يكفي لأن يجعل الروس يقدرون لأرجلهم قبل الخطو موضعها، نوويا على الأقل.
يتساءل المرء أين أوروبا على خارطة القوى والأقطاب الدولية؟
من أسف أظهرت أزمة أوكرانيا خواء حقيقيا في البنية التكتونية الأوروبية، والتي ضعضها الخروج البريطاني قبل عدة أعوام، وأضعفتها جائحة كوفيد-19، حيث أظهرت بوضوح حدود القوميات، وتفضيلاتها على الفكر الجمعي للأوروبيين.
يكاد المراقب المحقق والمدقق أن يقطع بأن واشنطن ومن خلال حرب أوكرانيا، قد وجدت طوق النجاة الذي يعيدها ثانية إلى قمة القطبية العالمية، لاسيما أن المشهد يكاد يتكرر مرة جديدة، بعد نحو ثمانية عقود من نهاية الحرب العالمية الثانية.
في نهاية ثلاثينيات القرن العشرين وجد الأوروبيون أنفسهم في مواجهة مزلزلة مع الفوهور أدولف هتلر، واليوم يكاد الرعب عينه يدب في نفوس الأوروبيين من قبل القصر بوتين، وصواريخه النووية الفرط صوتية المجنحة، والتي تتجاوز في بشاعتها، تلك الألمانية التي دكت لندن وعموم أوروبا دكا.
من جديد تلجأ أوروبا إلى العم سام، والحديث عن مئة ألف جندي أميركي يتم التخطيط لنشرهم في الداخل الأوروبي، قائم على قدم وساق، ومخازن الأسلحة الأميركية مفتوحة على مصراعيها للأوروبيين، كمحطة وصول، وقبل توجه الكثير منها إلى زيلينسكي في كييف.
ربما نجح الأوروبيون في تحقيق نمو اقتصادي ما، لكنهم فشلوا فشلا ذريعا في مقاربة النسر الأميركي من حيث قوته الاقتصادية من جهة، كما وقعوا في فخ القوة العسكرية للدب الروسي، والذي أضحى ثعلبا رشيق الخطى في السنوات الأخيرة من جهة ثانية.
خرجت أوروبا إذن من دائرة الأقطاب المتعددة التي توقعها ريتشارد هاس، وليس أدل على صدقية هذا التوجه من هروب مليارات الدولارات الأوروبية إلى الولايات المتحدة الأميركية بسبب الوضع الاقتصادي المتراجع.
أحد الأسئلة غير البريئة في سياق عودة القطبية الثنائية من جديد، موصول بالنوازع الأميركية وراء المشهد الأوروبي، وهل عمقت واشنطن الشرخ وجعلت منه فالقا بين موسكو وبروكسيل، وحتى لا تنشأ القارة الأوراسية التي تحدث عنها ونادى بها الجنرال الفرنسي الكبير والشهير، شارل ديجول، في نوبة صحيان لأهمية الاستفادة من الامتداد الجغرافي والديموغرافي لكل من أوروبا وآسيا.
تكاد أوربا في كل الأحوال أن تضحى الخاسر الأكبر من عودة الثنائية القطبية الروسية الأميركية، لاسيما وأن أهم أوراق القوة التي تقوم عليها الحضارة المعاصرة، أي الطاقة، لا تتوافر الإ لدى الطرفين الآخرين، وفيما موسكو تغلق أنابيب الغاز، تقف واشنطن حاملة لافتة ثيؤولوجية، يدركها أصحاب اليمين الأصولي هناك عنوانها: "لعل زيتنا لا يكفي لنا ولكن، فالأفضل أن تذهبن وتبتعن لكن"، وإلى حين وجود بائع آخر، تتهاوى الأركان التي كانت تدعم إرهاصات القطبية الأوروبية.
أين القطبية الآسيوية من المشهد الدولي المعاصر؟
الجواب يحتاج إلى قراءة قادمة قائمة بذاتها، لكن من غير اختصار مخل، تبدو الصين في وضع الطرف الحائر بعد الأزمة الأوكرانية بنوع خاص، فمن جهة لا يمكنها قبول فكرة هزيمة روسيا، ذلك أنه لو حدث، لوجدت نفسها في الميدان الأممى في مواجهة أميركا بمفردها، ومن ناحية ثانية، لا ترغب في أن توحل في الأزمة بالوقوف بالمطلق مع روسيا، إذ إن ذلك يعجل بصدامها مع واشنطن، ويجعل من فخ ثيوسيديديس أمرا واجب الوجود كما تقول الفلاسفة، وهو ما لا تسعى إليه في الوقت الراهن على الأقل.
هل من خلاصة؟
الضبابية سيدة الموقف الأممي، ولن تنجلي حكما، إلا بعد أن تنقشع غيوم الأزمة الأوكرانية، مخلفة من وارئها نهارا جديدا.
GMT 02:30 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السادة الرؤساء وسيدات الهامشGMT 02:28 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
«وثائق» عن بعض أمراء المؤمنين (10)GMT 02:27 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
من يفوز بالطالب: سوق العمل أم التخصص الأكاديمي؟GMT 02:26 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
روبرت مالي: التغريدة التي تقول كل شيءGMT 02:24 2022 الأربعاء ,02 تشرين الثاني / نوفمبر
السعودية وفشل الضغوط الأميركيةصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدمي عز الدين تعود بعد غياب طويل في اول ظهور فني لها بعد وفاة والدتها واستعداداتها لمفاجأة رمضان 2025
القاهرة - صوت الإمارات
بعد غياب طويل عن الساحة الفنية بسبب وفاة والدتها في نوفمبر الماضي، عادت الفنانة المصرية مي عز الدين أخيرًا للظهور، وذلك بعد فترة من الاختفاء أثارت قلق جمهورها. غابت مي عز الدين تمامًا عن وسائل الإعلام، ولم تظهر في أ...المزيدإلغاء ميتا التثبت من الحقائق سيكون له ضرر في العالم الحقيقي
واشنطن - صوت الإمارات
حذّرت شبكة دولية للتثبت من الحقائق، من أنّ توسيع شركة ميتا قرارها إلغاء التحقق من المنشورات على فيسبوك وإنستجرام سيؤدي إلى ضرر في العالم الحقيقي، نافية ادعاء مارك زاكربرج مؤسس شركة ميتا ورئيسها التنفيذي بأن الإشر�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدأحلام بإطلالات ناعمة وراقية في المملكة العربية السعودية
الرياض - صوت الإمارات
النجمة الإماراتية أحلام الشامسي كشفت أخيرًا عن ألبومها الجديد لعام 2025، وأفرجت الفنانة أحلام عن أولى اللقطات من كواليس وتحضيرات ألبومها الجديد، ونشرت فيديو عبر حسابها بانستجرام شوقت به الجمهور لأعمالها ومفاجآتها الفنية الجديدة من خلال الألبوم الجديد، وكتبت أحلام في تعليقها على برومو الكليب الجديد الذي بصدد طرحه قريبًا: "أحلام 2025" والذي تكهن البعض أنه سيكون عنوان ألبومها الجديد، بالإضافة إلى تعليقها على الفيديو "صنع في السعودية"، حيث اعتبر البعض أن تلك إشارة إلى أن أحلام صنعت ألبومها الجديد بالكامل في السعودية، وبالتزامن مع تلك المناسبة دعونا نرصد أجمل إطلالات النجمة أحلام خلال الفعاليات والحفلات التي حضرتها في المملكة العربية السعودية. إطلالات ناعمة وراقية من وحي النجمة أحلام في السعودية في حفل زفاف سابق قامت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©