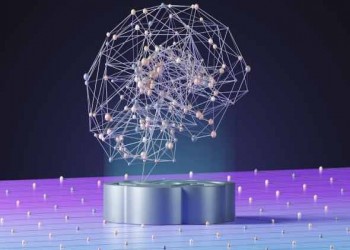الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
هل تصمد «كيانات ما بعد 1920» أمام انفجار إقليمي كبير؟
هل تصمد «كيانات ما بعد 1920» أمام انفجار إقليمي كبير؟

إياد أبو شقرا
بقلم - إياد أبو شقرا
أدرك سلفاً أنه في ظل الظروف السياسية المتوترة – كي لا نقول المتفجّرة – سيثير كلامي استنكاراً من بعض الجهات، واستغراباً وضيقاً في جهات أخرى. ولكن، أن أي شيء غير المصارحة سيكون في غير موضعه.
ما تجد منطقتنا نفسها فيه اليوم وضع في منتهى الخطورة، لا أبناؤها يعون كما يجب مخاطر تداعياته، ولا يكترث لهذه التداعيات «مجتمع دولي»... يفقد صدقيته بمرور الأيام والتجارب والاستحقاقات.
طبعاً، ثمة مَن يعتبر أن أقطارنا أعجز من أن تُحدث فارقاً أو تؤثر في مسار الأحداث، بدليل تكاثرها وتوالدها في كل زاوية تقريباً من زوايا عالمنا العربي. والحال، أننا لا نكاد نلجم إشكالاً حتى يستولد هذا الإشكال أزمة، ولا تكاد تظهر أزمة حتى يظهر مَن يسعى للاستفادة منها قبل أن تطوله شظاياها.
ولا حاجة، في زعمي، إلى هدر الوقت في التطرّق لكل من هذه الأزمات، ولكن لا بأس من تناول حالات بعينها... مع أن الانهيار الإقليمي ما عاد يميّز بين كيانات كبرى وأخرى صغرى، وهويّات سياسية ناضجة وأخرى طريّة العود، فـ«الدول الفاشلة» تقرئك السلام على مد النظر.
خلال الأيام الثلاثة الماضية هزّت لبنان جريمتا قتل، راح ضحية أولاهما باسكال سليمان منسّق حزب «القوات اللبنانية» في منطقة جبيل بشمال محافظة جبل لبنان، والثانية صرّاف اسمه محمد سرور... الموضوع اسمه على اللائحة الأميركية للمتهمين بالتعاون مالياً مع «حزب الله» وإيران وحركة «حماس».
جرت تصفية سليمان، وفق رواية «رسمية»، أثناء عملية «سرقة استهدفت سيارته». إلا أن التفاصيل التي بدأت تتكشّف حتى قبل العثور على الجثة، وتنقّلت «محطاتها» الحَدَثية بين لبنان وسوريا، أوحت بأي شيء إلا دافع السرقة.
بالنسبة إلى عملية تصفية سليمان، ربطت جهات لبنانية عديدة الجريمة باللاجئين والنازحين السوريين... وأيضاً بالسلاح «غير الشرعي». وفي شأن هذا السلاح تلميح واضح إلى «حزب الله»، وسط الكلام عن احتمال تورّطه بمواجهة مع إسرائيل ضمن نطاق «وحدة الساحات» المحيطة لإسرائيل، وتضامناً مع طهران في انتقامها الموعود رداً على قصف قنصليتها في دمشق.
وللعلم، فإن منطقة جبيل منطقة مختلطة أكبر مكوّناتها المذهبية الموارنة والشيعة، وكانت قد شهدت خلال الشهور الأخيرة إشكالات وخلافات متعدّدة حول ملكية الأراضي، والتحرّكات السياسية والحزبية.
ثم إن الساحة المسيحية عموماً في لبنان، عرفت ولا تزال تعرف، ارتفاعاً في مستوى التحريض الشرس على اللاجئين والنازحين السوريين. وبالتالي، جاءت جريمة قتل سليمان لتضرب عصافير عدة بحجر واحد، أهمها:
1- وجود «صلة ما» لسوريا كأرض، والسوريين كأفراد، بما حدث.
2- تخويف المسيحي اللبناني من اللاجئ والنازح السوري كي يكثّف المطالبة بعودته، مع أن السبب الأساسي لبقاء اللاجئين هو رفض نظام دمشق عودتهم بعدما أقدم عمداً على تهجيرهم.
3- خلق جو من الفزع في لبنان ينتهي بالتسليم لمنطق السلاح، وتركه وشأنه في تقرير مصير البلد... حرباً أو عبر صفقات تكون إيران طرفاً أساسياً فيها.
4- توجيه رسالة غير مباشرة إلى طوائف لبنان الأخرى مؤداها أن عليها تقبّل بقاء قرار الحرب والسلم بيد «حزب الله» وما «يستولده» حالياً من تنظيمات مسلحة تابعة له داخل تلك الطوائف وتسير وفق إرادته وتعليماته.
علامات الاستفهام مستمرة في حالة قتل الصرّاف سرور، الذي استدعته امرأة إلى فيلا خارج بيروت بحجة إتمام تداول مالي، ولم يَعُد منها إلا جثة هامدة!
تصفية الرجل، بالطريقة المرسومة والمنفذة بدقة تؤكد المؤكد... وهو قوة نشاط أجهزة الاستخبارات الإقليمية، وبالذات «الموساد»، الذي يستطيع – كما بدا منذ تصفية القيادي «الحمساوي» صالح العاروري – الوصول إلى أهدافه داخل لبنان، وأيضاً داخل سوريا والعراق، بكل ثقة ويُسر.
«الموساد» موجود ومتحرك ويده طائلة... كما يقال بالعامية اللبنانية. وإسرائيل تفهم ما سيعنيه تهجير عشرات ألوف الجنوبيين الشيعة إلى الداخل اللبناني إذا تفجّر الوضع الحدودي، وبالأخص، في المناطق المتداخلة والقلقة طائفياً. وبالتالي، لا يجوز إسقاط احتمال الفتنة الداخلية... إذا كانت مطلوبة إسرائيلياً وبتواطؤ أميركي وأوروبي.
في أي حال، هذا «السيناريو» قد ينطبق بطبيعة الحال على الأردن وسوريا أيضاً.
ذلك أن خرائط عام 1920، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، خلقت الحدود الحالية بين لبنان وسوريا والأردن والعراق. وإيران أنجزت فعلياً منذ 2003 «إزالة» هذه الحدود عبر هيمنتها على العراق، ثم وضع يدها على سوريا، التي حُوّلت إلى «جسر» يصل الوجودين الإيرانيين المتحكمين بالعراق ولبنان. ومن ثم، بعد سكوت العالم عن ضرب طهران وموسكو انتفاضة الشعب السوري عام 2011، أطلقت طهران عملية استيطان واسعة ومستمرة في جهات عديدة من سوريا.
من ناحية أخرى، شدّدت طهران قبضتها على العراق، وها هو تصعيد بعض الفصائل العراقية المسلحة الإيرانية التوجيه يستهدف اليوم الأردن، مباشرة، من الشرق. وهنا، رد الفعل العاطفي والقومي عند كثيرين مفهوم، بل ومقدّر... لكن «الشيطان يكمن في التفاصيل»، كما يقال. فأنا لا أشك لحظة في أن القيادات الإسرائيلية «الترانسفيرية» المتطرّفة لا تمانع في انهيار الكيان الأردني إذا كان هذا الانهيار سيسهّل التهجير النهائي شرقاً لفلسطينيي الضفة الغربية.
و«السيناريو» نفسه ينطبق على إعادة تشكيل لبنان بعد إبعاد أبناء الغالبية «الحدودية» الشيعية شمالاً إلى الداخل اللبناني... من أجل إرباك الوضع واستنفار الغرائز.
وكذلك يمكن تصديره إلى سوريا، التي غدت واقعياً بلاداً بلا سيادة موزّعة النفوذ، بين الروس في الشمال الغربي (جبال العلويين ووادي النضارة والمدن الساحلية)، والأتراك في المنطقة الممتدة من إدلب فحلب إلى نهر الفرات، والأميركيين والأكراد في مناطق شرقي الفرات (محافظتا الحسكة والرقة وشمال دير الزور)، ثم «الممر الإيراني» من بغداد فالبوكمال نحو بيروت مروراً بدمشق، ولا يبقى خارج هذه المعادلة راهناً سوى الجنوب السوري، أي سهل حوران (درعا) وجبل حوران (السويداء).
إننا نعيش ساعات صعبة مفتوحة على كل الاحتمالات في غياب القدرة العربية على التحكم بالأحداث، والتطرّف الإسرائيلي المجنون الذي لا يرى مَن يلجمه، ومؤسسات دولية عاجزة تعيش في ظل قيادات متواطئة أو قاصرة أو شعبوية، وكل هذا في سنة انتخابات رئاسية أميركية غير كل السنين وكل الانتخابات!
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©