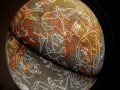الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
أزمة الصحافة.. وبدائل «الاتحاد»
أزمة الصحافة.. وبدائل «الاتحاد»

رضوان السيد
بقلم : رضوان السيد
خطت صحيفة «الاتحاد» الخطوة الرابعة أو الخامسة في السنوات الأخيرة في سبيل التطوير. بيد أنّ الخطوة الأخيرة التي أُعلنت قبل أسبوع كانت الأكثر جرأةً والأكثر ملاءمةً للأساليب الجديدة في الإعلام ووسائل التواصل. هناك أزمة طاحنة تمرُّ بها الصحافة الورقية منذ مطلع القرن العشرين، وهي تتفاقم عاماً بعد آخر، وصارت أخيراً شهراً بعد شهر. ويرجع ذلك لعوامل معرفية ومنهجية ومهنية ومالية. فالصحافة في الأصل صحافة خبر، ومنذ مدة حل التلفزيون محل الصحافة في تقديم الخبر، لأنه أسرع وأكثر قدرةً على التجاوب. والآن توشك وسائل التواصل الأُخرى أن تحل محل التلفزيون، لولا الصورة والحيوية (غير الشخصية) التي تتسم بها المشاهد التلفزيونية المصاحبة للأخبار. وقد حاولت الصحافة أن تتجاوز هذا القصور بالصيرورة إلى التحليل أو ما وراء الخبر. وقد نافسها في ذلك أيضاً التلفزيون الأكثر سرعةً وقدرة على استجلاب الخبراء والمتخصصين. لكن إذا كان التحليل مستوفياً يكون طويلاً، وهذا لا تتحمله الصحافة اليومية ولا يتحمله أهل التلفزيون، لذا صار الرأي إلى المجلات المتخصصة وشبه المتخصصة التي لا تقرؤها غير النُخَب، ولذلك تحتاج للدعم من الحكومات أو من مؤسسات علمية واستراتيجية كبرى. أما الفهم السريع للحدث وما وراءه فبقيت بقيةٌ منه في الصحف.. لكن أيضاً في وسائل التواصل الأُخرى.
والصحافة حرفةٌ عريقةٌ يصل عمرها نحو المائتين وخمسين عاماً. وقد كانت في حراسة الحكومات ولتسجيل أعمالها، ثم اختلط النوعان الحكومي والحر. أما المعارضة والثقافة فكانتا غالباً في المجلات التي ظهرت بالمشرق في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. أي أن مهنة الصحافة صارت، إذا أُريد لها الإتقان، شديدة التعقيد وكبيرة الأعباء. حتى قيل في فترة إنّ التلفزيون أقل تكلفةً من صحيفة عريقة وشاسعة الاهتمامات مثل «لوموند» و«التايمز» و«نيويورك تايمز» و«وشنطن بوست».
وعلى أي حال فإنّ المهتمين والمشاركين في القرار وأصحاب المصالح والاستراتيجيات الكبرى، صاروا منذ مدة يؤْثرون الاستثمار في شركات التلفزيون أو في وسائل التواصل التي صارت محبوبةً جداً لدى الشباب مثل الأنواع المختلفة للرياضة.
وعلى أي حال، ثقافة ما بعد الحداثة أو ثقافة وسائل التواصل هي نوعٌ جديدٌ من الثقافة، مثل الانطباعية بين مدارس الفن الحديث. إذ هي توهِمُ بخصوصيةٍ وحجيةٍ شديدة، وبأنّ الفرد هو الذي يصنع الحدث، ويشارك على قدم المساواة مع الآخرين، ويُعرض عما لا يريد، ويصنع ويشجّع ما يريد. كل هذه الاهتمامات والهموم كانت محل اعتبارٍ ومراجعة ومتابعة ونقد من أهل الصحافة الكبار، ومن المسؤولين الحكوميين، وبخاصة في البلدان الغربية، لأن هناك قيماً أصليةً في الحريات الأساسية وحرية التعبير ارتبطت كلها بالصحافة المكتوبة التي أسهمت حتى في إنتاج الدساتير والقوانين. ونتيجة لهذه التقديرات، برزت مسالك لمعالجة أزمة الصحافة. فصارت بعض الصحف مِلْكاً لرجال الأعمال الكبار، وبعض هؤلاء دخلوا على الصحافة بعد دخولهم على وسائل التواصل، فأفادوا لهذه الناحية بالوصل بين الإلكتروني والورقي، لكنهم أضروا في مسألة الحرية، لارتباط الإعلام بمصالحهم التجارية والسياسية.
أما المسلك الآخر فكان إقفال الصحيفة، لعجز مادي أو باعتبار أن وظيفتها انتهت.
والمسلك الثالث هو مسلك صحيفة «الاتحاد» الغراّء، والتي ربطت الورقي والإلكتروني بوسائل التواصل الأخرى المتكاثرة. ولأنها صحيفة تاريخية، لارتباطها بتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فلديها هذه الذاكرة الخالدة من جهة، ورسالة التسامح والتعدد والاتحاد من جهة ثانية. وهاتان رسالتان لا تمتلكهما أي وسيلةٍ إعلاميةٍ أُخرى. فإذا اجتمعت لديها وبأسلوب شائقٍ وموجز الرسالتان، إلى النهج الإلكتروني، وثقافة وسائل التواصل في الجزء المحترم والإنساني منها، فإنّ ذلك حري بأن يمنحها عمراً جديداً مستحقاً.
نحن متحيزون لأننا من جيلٍ تربى على الصحافة الجادة والمشرقة في الخبر والتحليل. لكننا أيضاً نفهم ضرورة الاستجابة لتحديات الحاضر، وهو أمر قامت به «الاتحاد»، والذكر للإنسان، كما يقول المتنبي، عمرٌ ثاني.
*أستاذ الدراسات الإسلامية بالجامعة اللبنانية -بيروت
GMT 21:31 2024 الأربعاء ,23 تشرين الأول / أكتوبر
كهرباء «إيلون ماسك»؟!GMT 22:12 2024 الثلاثاء ,22 تشرين الأول / أكتوبر
لبنان على مفترق: السلام أو الحرب البديلةGMT 00:51 2024 الأربعاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر
مسألة مصطلحاتGMT 19:44 2024 السبت ,12 تشرين الأول / أكتوبر
هؤلاء الشيعة شركاء العدو الصهيوني في اذلال الشيعة!!GMT 01:39 2024 الجمعة ,11 تشرين الأول / أكتوبر
شعوب الساحاتصندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدأصالة تحتفل بفوزها بجائزة "جوي أوورد" للعام الثاني وتستعد لإهداء الجمهور أغنية جديدة "ممنوع"
الرياض - صوت الإمارات
الفنانة أصالة خطفت الأنظار في حفل توزيع جوائز "جوي أوورد" بعدما فازت بجائزة المغنية المفضلة للعام الثاني على التوالي، وعاشت الفنانة أصالة عام مليء بالإنجازات والأعمال الفنية المتنوعة والتي جعلتها تستحق الفو�...المزيدماسك يحذر من "هلوسة" الذكاء الاصطناعي بسبب نفاد البيانات على الإنترنت
واشنطن - صوت الإمارات
في تحذير جديد أطلقه إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا وSpaceX، حذر من خطر "هلوسة الذكاء الاصطناعي" في المستقبل القريب، وذلك بسبب احتمالية نفاد البيانات المتاحة على الإنترنت لتدريب الأنظمة الذكية. وتوقع ماسك أن الذكاء ا�...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدأحلام بإطلالات ناعمة وراقية في المملكة العربية السعودية
الرياض - صوت الإمارات
النجمة الإماراتية أحلام الشامسي كشفت أخيرًا عن ألبومها الجديد لعام 2025، وأفرجت الفنانة أحلام عن أولى اللقطات من كواليس وتحضيرات ألبومها الجديد، ونشرت فيديو عبر حسابها بانستجرام شوقت به الجمهور لأعمالها ومفاجآتها الفنية الجديدة من خلال الألبوم الجديد، وكتبت أحلام في تعليقها على برومو الكليب الجديد الذي بصدد طرحه قريبًا: "أحلام 2025" والذي تكهن البعض أنه سيكون عنوان ألبومها الجديد، بالإضافة إلى تعليقها على الفيديو "صنع في السعودية"، حيث اعتبر البعض أن تلك إشارة إلى أن أحلام صنعت ألبومها الجديد بالكامل في السعودية، وبالتزامن مع تلك المناسبة دعونا نرصد أجمل إطلالات النجمة أحلام خلال الفعاليات والحفلات التي حضرتها في المملكة العربية السعودية. إطلالات ناعمة وراقية من وحي النجمة أحلام في السعودية في حفل زفاف سابق قامت...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©