الرئيسية
أخبارعاجلة
رياضة
- أخبار الرياضة الإماراتية والعربية والعالمية
- أخبار الرياضة والرياضيين
- فيديو اخبار الرياضة
- نجوم الملاعب
- أخبار الرياضة
- ملاعب
- بطولات
- أندية الإمارات
- حوارات وتقارير
- رياضة عربية
- رياضة عالمية
- موجب
- سالب
- مباريات ونتائج
- كرة الطائرة
- كرة اليد
- كرة السلة
- رمي
- قفز
- الجري
- تنس
- سيارات
- غولف
- سباق الخيل
- مصارعة
- جمباز
- أخبار المنتخبات
- تحقيقات
- مدونات
- جمباز
ثقافة
إقتصاد
فن وموسيقى
أزياء
صحة وتغذية
سياحة وسفر
ديكور
أثار بعض النقاشات المتفاوتة وكل طرف يمتلك حجة تدعم موقفه
فيلم الـ "جوكر" وغياب عدوه اللدود "باتمان" في ثنائية الخير والشر

فيلم الـ "جوكر"
واشنطن - صوت الإمارات
نادرا ما أثارت بعض الأفلام نقاشات وتحليلات متفاوتة الأهمية ومتناقضة أحيانا، مثل ما حدث مع فيلم "جوكر" للمخرج الأمريكي تود فيليبس. والحقيقة أن كل الأطراف لها من الحجج ما يدعم موقفها.
فالمعارضون يأسفون لفكرة تقزيم شخصية "جوكر الشرير"، المبتكرة في أربعينيات القرن الماضي، ولتجسيده في صورة مهرج مهزوز، زادت من حدة اضطرابه النفسي قساوة مجتمع لم يرحمه، والتي كسرت ملامحه كمجرم لا يتوانى في التلذذ بقتل كل من اعترض سبيله، بل وجلبت تعاطف شريحة المستضعفين الذين جعلوه رمزا للكفاح ضد جبروت السلطة الاقتصادية والسياسية المهيمنة في أمريكا (بعض المحللين لم يترددوا في مقارنة هذه الانتفاضة مع تلك التي عاشتها فرنسا مع ثورة "البدلة الصفراء" ومع ما سمي بـ "الربيع العربي".
كذلك انتقدوا غياب البطل الأسطوري والمحوري الذي انبعث من صلبه "جوكر" والذي يقع على النقيض المطلق منه، أي عدوه اللدود "باتمان" مناصر العدالة والخير، من بدونه يفقد مغزى وجوده، بل ذهب بعضهم إلى حد اتهام الفيلم بتمجيد العنف في بيئة صارت تستهويها القوة بديلا عن قيم الحوار والتسامح.
أما المعجبون فقد أشادوا بالعمل كإنجاز سينمائي وكمضمون تجاوز الثوابت المعهودة في الأفلام المؤسسة لأسطورة "باتمان"، وذلك بطرحه مسألة الخير والشر من زاوية نفسية عميقة يندحر فيها البطل الهلامي لفائدة الإنسان الواقعي. وقد لا نعدم برهانا لو أجزمنا بأن قوة الفيلم تكمن بالذات في افتقاد الإجماع حوله، باستثناء الإشادة بالأداء المميز لـ "يواكين فينيكس" في دور "آرثر فليك"، الذي انغمس بالمطلق في الشخصية لحد جعل المتفرج لا يفرق بين الممثل والإنسان.
وسواء اتفقنا أو اختلفنا حول خلفية الفيلم، فمن المؤكد أن بصمته طبعت الجميع لدرجة يستعصي فيها خلق مسافة تباعدية معه، نظرا لغزارة دلالاته وتعدد إيحاءاته الفكرية والسياسية والسينيفيلية (خصوصا مارتن سكورسيزي في فيلم "سائق التاكسي").
ففيلم جوكر يتأسس كلوحة "نيتشية" في فلسفتها وسوداوية في مضمونها وتعبيرها (يقول "آرثير" في إحدى اللقطات للطبيبة المعالجة: إنني لا أحمل سوى أفكار سوداء) يلتقي فيهما الواقعي بالخيالي والحقيقي بالوهمي: مثلا علاقة "آرثير" بجارته "صوفي" (زازىبيتز) التي كان يتربص بها في طريق العمل لم تكن إلا من نسج خياله. وفي هذا السياق تحتل الألوان دورا مركزيا في بناء شخصية هذا البطل السلبي الذي تأخذ ألبسته ألوانا تتغير من أخضر وبنفسجي إلى أصفر وأحمر، حسب انتقاله من مرحلة المهادنة والسلم إلى مرحلة الضغينة والشر.
موسيقى وألوان تغذي أجواء الهيستيريا والكآبة
تدور أحداث الفيلم في مدينة غوثام عند بداية الثمانينيات التي أفلح مهندس الديكور ومدير التصوير في رصد مناخها بدقة فائقة، لا من حيث أجوائها العامة ولا من حيث الإنارة والملابس. كما أن الموسيقى التصويرية الحزينة والصاخبة جاءت متناغمة مع الألوان لتعطينا تحفة بصرية تزيد تفاعلا في معالجة موضوع الهيستيريا والكآبة التي يطرحها الفيلم، فكان لها كبير الأثر في خلق الإحساس بالعزلة والرعب التي تعيشها المدينة.
في إحدى أحياء هذه المدينة المهمشة والفقيرة يقطن "أرثير"، ممثل كوميدي بشخصية مهرج يسعى إلى إضحاك الجمهور فيصبح هو نفسه، وهنا المفارقة، أضحوكة الجمهور. ولأنه لا يندمج في المجتمع، فقد ظل الفشل يلاحقه في كل مرة يقف على الخشبة، إذ لم يفلح قط في إقناع الجمهور بالنكت التي يسطرها في دفتر سرعان ما يفقد الخيط الناظم لها تحت وطأة اضطرابه النفسي والذي يترجمه في ضحكة هستيرية فاقدة للمعنى أو أنها بالأحرى تتفجر، بالرغم عنه، كتعبير عن مدى القلق والتوتر الدفين لديه.
لقد خرج آرثير" للتو من إحدى مصحات الأمراض العقلية واستقر مع أمه العجوز "بيني" (فرنسيس كونروي) التي تعاني بدورها من تبعات جلطة دموية ألزمتها الفراش، في شقة مهترئة بإحدى أفقر أحياء المدينة. يلتقي "موراي فرانكلين" (روبرت دو نيرو الذي أتحفنا كعادته بأدائه المحكم) مقدم برنامج حواري الذي يحتضنه كموهبة فريدة، قبل أن تتبدى له تدريجيا تفاهته كممثل كوميدي يجب استغلال ضعفه للرفع من درجة تتبع برنامجه، دون اكتراث بالحالة المرضية التي يمر منها. وهنا نصادف مفارقة أخرى تفصح عن استرخاص الإعلام الرأسمالي للكرامة الإنسانية حيت بقدر ما كان النجم التلفزيوني "موراي فرانكلين" يكبر في أعين "آرثر"، بقدر ما كان هذا الأخير يتضاءل بالنسبة إلى الأول الذي يحوله إلى مجرد فقرة من فقرات عرضه الساخر.
سينما المؤلف
هناك في رأيي محطتان بارزتان على الأقل في الفيلم تشكل الإطار العام الذي يحدد الكيفية التي تميز الكتابة السينمائية عند "تود فيليبس" كمخرج لم يكن أحد، بالنظر إلى أعماله السابقة المتواضعة نسبيا رغم حرفيتها، يتنبأ بقفزته لدرجة "سينمائي مؤلف":
-الأولى تنطلق مع بداية الفيلم التي نرى فيها "آرثير" أمام المرآة، متنكرا خلف قناع من المساحيق استعدادا لتقديم فرجة مسلية في الشارع مؤدى عنها، كما جرت العادة بالنسبة إلى البهلوانيين قبل أن تجرف مهنتهم، موجة الليبرالية العنيفة التي انطلقت شرارتها مع وصول "ريغان" و"تاتشر" إلى الحكم. هنا ينبهنا المخرج ضمنيا إلى أننا أمام شخص مزدوج الهوية.
تتوالى اللقطات والمشاهد بكثير من التفصيل والتدقيق بغية حمل المشاهد على استبطان فكرة الاضطهاد الذي يمارس على "آرثير"، ليس فقط من جانب علية القوم، بل وحتى من المضطهدين مثله. فمنذ البداية يتعرض لاعتداء مجاني من طرف شباب متهور، ينتزعون ويكسرون لوحته الإشهارية، فلا يجد أذنا صاغية لدى المسؤول عن الوكالة المشغلة إذ يلزمه باسترداد اللوحة أو خصم ثمنها من أجرته. في هذا الظرف يتطوع "راندال" أحد أصدقائه في العمل لتسليمه مسدسا للدفاع عن نفسه، لكننا نكتشف لا حقا أن هديته المسمومة ستكون نقمة عليه إذ بسببها سيطرد مرة أخرى من العمل، بعد أن سقط منه المسدس سهوا أثناء عرضه البهلواني في مستشفى للأطفال، كما أن الهدية كانت لأجل إثبات جريمة القتل ضده، بعد أن أوشى به صديقه.
-المرحلة الثانية يمكن رصدها من خلال علاقته بأمه التي ظل يشملها بالرعاية والحنان، قبل أن يدرك عن طريق مراسلاتها القديمة مع مشغلها الغني "توماس واين" (بريس كولن "المرشح لعمادة المدينة -والذي هو في الوقت نفسه الأب الشرعي لـ "بروس أو باتمان في طفولته" واللاشرعي لـ "جوكر"- بأنها سبب كل مآسيه من جراء الإهمال والتعذيب الذي لاقاه على أيديها في طفولته، بل وأنها هي من قبلت شرط التبني الذي أرغمها عليه هذا الأخير بعدما أنجبت منه. هنا نفهم أن المخرج قد وضع بين أيدينا تفسيرا لعقدته النفسية تجاه النساء اللواتي يرى فيهن صورة أمه، وبالأخص الطبيبتين النفسانيتين اللتين ظل يتهمهما بعدم الإنصات لمعاناته. وما يزكي هذا الطرح في نظري هو الاستمرار شبه الكلي لوضع مسافة فاصلة بينه وبين أمه في المشاهد التي تجمعهما.
-أما المرحلة الثالثة، فتمر عبر الاعتداء عليه من طرف ثلاثة شبان من أبناء البورجوازية "المتعفنة" كانوا يتحرشون بفتاة بسيطة داخل مقصورة "ترامواي"، تحت أنظار "آرثر" الذي ينطلق في ضحكته المرعبة، قبل الإقدام في لحظة دفاع عن النفس، على قتلهم بغير قليل من التلذذ.
انطلاقا من هذه اللحظة تتفجر تصاعديا ضغينته المضمرة في سيل من الجرائم ضد كل الذين عاملوه بازدراء، بدءا بصديقه "راندال" ثم "توماس واين"، فـ "موراي فرانكلين" ثم أمه بعد الصدمة التي تلقاها إثر اكتشافه حقيقة معاملتها له في صغره وانتهاء بالطبيبة النفسانية في لقطة رمزية عند نهاية الفيلم، حينما كان يسير حافي القدمين والدم يرسم بصمات رجليه على الأرض.
لقد أصبحنا بعيدين كل البعد عن الشخص البئيس والمتهالك الذي بالكاد يصعد الأدراج، لنواجه جسدا مقنعا ومرحا يغيث في رقصة تنازلية نحو الجحيم، موقعا بذلك ميلاد "جوكر". ومن غريب الصدف أن يصبح مبجلا كرمز للاحتجاجات والتمرد الشعبي حينما تتحقق نقلته من الكوميديا إلى التراجيديا.
إن هذه النسخة الأخيرة من سلسلة الأفلام الهوليودية حول "جوكر"، قد شكلت ضربة موجعة لصانعي الرأي العام، في ظل عالم رأسمالي متوحش، يزدري المهمشين ويضع في هرم السلطة من يفبركهم مجتمع الفرجة كنماذج للنجاح الاجتماعي من أمثال "واين"، وهنا تكمن إحدى نقاط القوة في السيناريو التي تفسر ردة الفعل العنيفة لذوي القرار في "أمريكا ترامب"، الذين يتذرعون بكون الفيلم يمجد العنف. وهل يوجد عنف أكبر من ذاك الممارس في ظل نسق سياسي واقتصادي فرداني أودى بشخص مسالم للوقوع في مستنقع الجريمة؟
هنا نصادف الفرق الكبير من حيث الطرح بين "جوكر" تود فيليبس" والأفلام السابقة التي ركزت على البطل العادل "باتمان" في صراعه مع غريمه الشرير "جوكر"
قد يهمك أيضًــــــــــا:
أشهر 7 ثنائيات فى هوليود يصل الفارق العُمري بينهما من 10 سنوات لربع قرن
GMT 19:49 2020 الثلاثاء ,18 شباط / فبراير
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يكشف تفاصيل دورته الافتتاحيةGMT 08:19 2020 الأحد ,16 شباط / فبراير
مسرح مول الإمارات يعرض مسرحية"شجرة التين" لرائدة طهGMT 20:46 2020 السبت ,15 شباط / فبراير
استقالة جماعية تعصف بـ "سيزار" الفرنسية للسينماGMT 11:38 2020 السبت ,15 شباط / فبراير
لطيفة تروج لأحدث أغانيها "أقوى واحدة" بعد يوم واحد من طرحها على "يوتيوب"GMT 10:16 2020 الجمعة ,14 شباط / فبراير
عمرو دياب يُعلن عن إطلاق ألبومه الجديد "سهران" عبر "فيسبوك"صندوق النقد يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بنسبة 5.1% في 2025
دبي - صوت الإمارات
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4 بالمئة في العام 2024، ومن ثم ترتفع إلى 5.1 بالمئة خلال العام القادم 2025.وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر �...المزيدنانسي عجرم تكشف تفاصيل فيلمها المنتظر مع عمرو دياب وتتحدث عن أمنياتها للعام الجديد
القاهرة - صوت الإمارات
في لقاء مصور مع الإعلامي ربيع هنيدي، على هامش إحيائها حفل رأس السنة في دبي، تحدثت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن العديد من المواضيع الشخصية والفنية، مشيرة إلى أبرز تطورات حياتها المهنية خلال الفترة المقبلة، بالإ�...المزيدإسرائيل تعتمد على الذكاء الاصطناعي في حرب غزة لتسريع العمليات العسكرية و"خوارزميات القماش" تحدد مواقع صواريخ حماس
غزة - صوت الإمارات
بعد الهجوم الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أمطر الجيش الإسرائيلي قطاع غزة بالقنابل، معتمداً على قاعدة بيانات جمعها بعناية على مدار سنوات، تضم تفاصيل عناوين منازل ومواقع أنفاق وبنية تحتية بالغ...المزيدبرنامج أمير الشعراء يختتم المرحلة الأولى في موسمه الـ11 ويعلن عن المتأهلين
أبوظبي ـ صوت الإمارات
اختتم برنامج أمير الشعراء، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، المرحلة الأولى من موسمه الحادي عشر، بالحلقة المباشرة الخامسة التي بُثت مساء أمس الخميس 2 يناير 2025، وذلك من على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي.وخلال هذه الحلقة ت...المزيدنجم منتخب البرازيل وريال مدريد فينيسيوس جونيور يفوز بجائزة الأفضل لعام 2024
الدوحة - صوت الإمارات
حصد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024، خلال حفل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المقام مساء الثلاثاء، للكشف عن الفائزين بـ جوائز The Best من فيفا لعام 2024 وأبرزه�...المزيدبيلا حديد في إطلالات عصرية وجذّابة بالدينم
القاهرة - صوت الإمارات
أطلت العارضة الحسناء بيلا حديد Bella Hadid لافتتاح متجر مؤقت لماركتها في نيويورك لمناسبة موسم الاحتفالات، بلوك راقٍ وعصري في الوقت نفسه تَمثَّل بسروال ضيق من الدنيم مستقيم القصة مع بلوزة حمراء بقصة كورسيه، ومزدانة بصف أمامي من الأزرار، وتدثرت بمعطف من الكشمير الأبيض الدافئ، وانتعلت صندلاً عالياً باللون الأحمر، وحملت حقيبة جلدية سوداء بحجم كبير وزينت المقبض بوشاح حريري مطبع باللونين الأحمر والأبيض والأسود. كما وضعت العارضة الحسناء نظارات طبية شفافة بإطار أسود وتصميم بيضاوي، وتزينت بأقراط مثبتة على الأذن، فيما أرخت شعرها الناعم الطويل على كتفيها. بيلا حديد Bella Hadid في نيويورك - (مصدر الصورة- via Getty Images By Aeon/GC Images) كيف تنسقين إطلالاتك بالدنيم بأسلوب بيلا حديد؟ منذ انطلاقتها في عالم عروض الأزياء ظهرت بيلا حديد بالعديد من الإطلالات ا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©









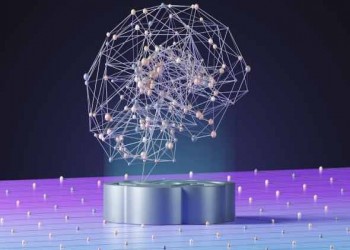











أرسل تعليقك